شاعر سوداني جديد القصيدة جزءاً من هوية بلاده ..
متوكل زروق : حصة « اللغة العربية » أشعلت قناديل الكلام داخل روحي .
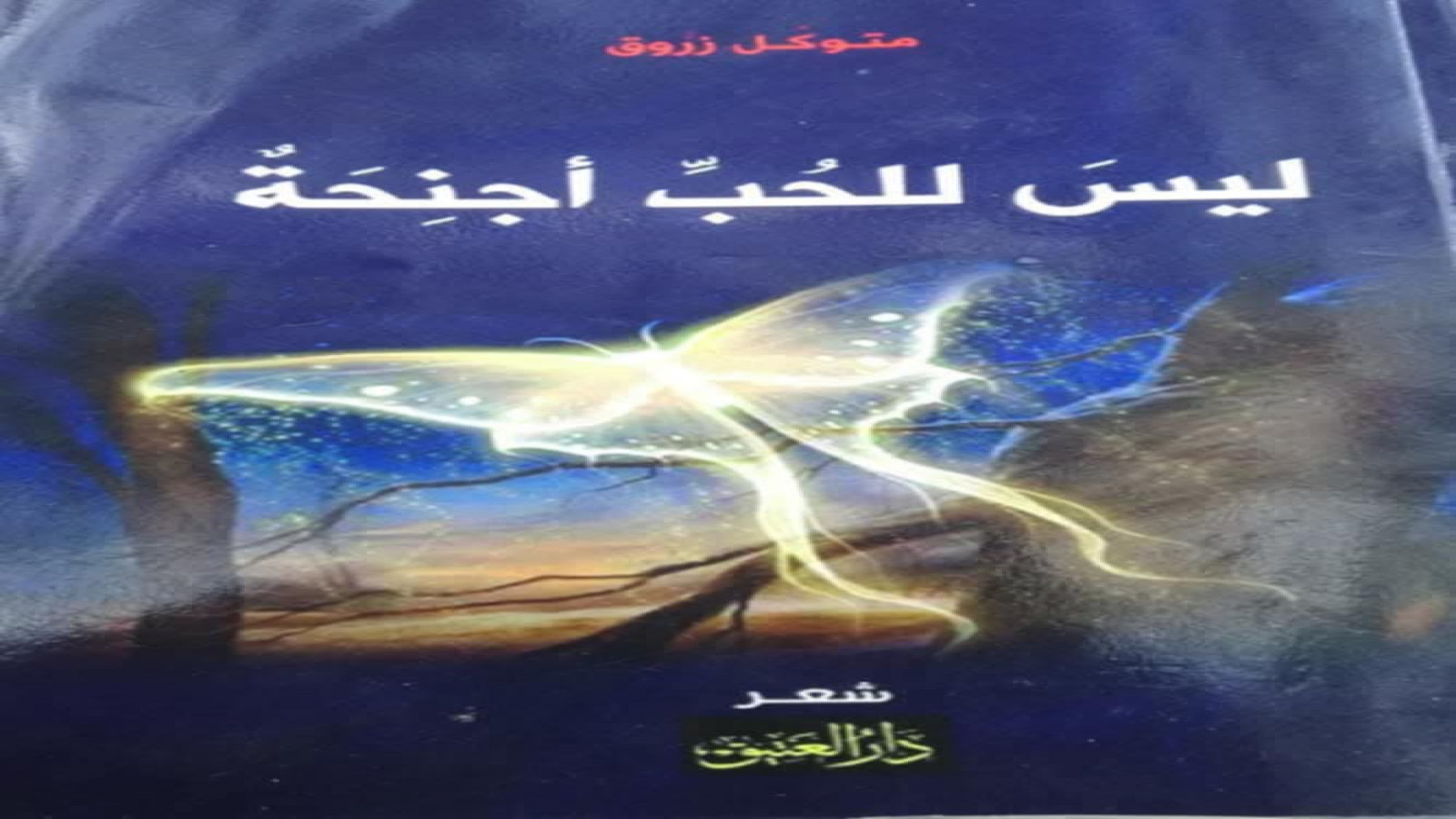
الشاعر السوداني متوكل زروق، تجربةٍ لا تتخذ القصيدة أداة للقول، بل طقس كشف، لا تستسلم للمباشرة، ولا تخشى المشي في العتمة وهي تمسك بفتيلها الخاص. تخطّت تجربته حدود الكتابة إلى حضور متميز في المشهد الثقافي والمهرجانات الأدبية داخل السودان وخارجه. وصدرت له عدة دواوين منها: «اقتراحي للربيع»، «مغرّم بيديك هذا العود»، «ربما أزرق اللون»، «نعوش»، «ليس للحب أجنحة»، و«وأعلى صدى للكون». نال خلال مسيرته الأدبية عدة جوائز أبرزها جائزة مهرجان سحر القوافي عام 2013، وجائزة مهرجان الثقافة السادس بالخرطوم عام 2015. في موازاة انشغاله بالشعر، يواصل زروق مشروعه الثقافي عبر دار الأجنحة، التي لا تكتفي بالنشر، بل تنفتح على المعرفة بوصفها جسرًا متبادلاً؛ بين ما يُكتب هنا وما يُقرأ هناك هل ما زلت تصغي إلى الطبول الأولى في لغتك؟ إنها في دمي، وهي هيَّاجة لا تعرف السكون، أستمع لها وعلى إيقاعها أبكي وأُغني، أُعزِّي وأكتب الشعر، وأجعلها دائمًا قُربانًا لِلُمعة الروح وجوهرةً حلَّاقة في عتمتها. في السودان، حيث الذاكرة المثقلة بالتحوّلات، هل تنحاز للقصيدة كأرشيف، أم كتحرّر من الذاكرة؟ إن الأرض التي تشكَّلت فيها بيئة التكليف بهم الشعر، جديرةٌ بألَّا تجعل من القصيدة خِدرًا لثنائية الذكرى والنسيان، وبألَّا تُستخدم كأداة لقرضٍ محدد، إنما هي في السودان، حياةٌ تحرك الأشياء وتجعل منها بريقًا في الذاكرة في كل ما هو إنساني وملهم، الشعر جزءٌ أصيلٌ من ذاكرة السودان، لا طارئا عليها. ظلت القصيدة السودانية دومًا شدوا بين لسانين: فصحى ومحلّية، بين مدنية وهوامش، كيف وجدت قصيدتك مسارها داخل هذا التداخل؟ منذ أيامنا الأولى ونحن نتلمَّس طريق الشعر، كنت أطرح أسئلةً وأنا أحاول التعرف على التراث الشعري، فصيحه والعامِّي، ( هل حاجة الناس للشعر مستمرة؟، بعد كل هذه التجارب الشعرية العظيمة، هل نحن قادرون على إضافة شيء؟، ما الماعون الأمثل لحمل خطابي الشعري للناس؟) فمن خلال الأجوبة عن هذه الأسئلة، اعتقدت أن حاجة الناس للشعر مستمرة، وستبقى مستمرة وراسخة، بدليل المسافة الزمنية، مذ علم الله آدم الأسماء كلها وقد كان الشعر اسماً من تلك الأسماء، مروراً بــ(الأفوه الأودي) وكل الحقب الشعرية التي تلت زمانه وإلى الآن، إن لم تكن هناك حاجة له لما وصلنا هنا الآن. ثم أننا قادرون على وضع سهمنا في كنانة الشعر طالما (لكل زمانٍ رجال) وطالما كان لكل حقبة من حقب التراث الشعري قيمتها واختلافها وقدرتها على التعريف بأحوال تلك الأزمنة وناسها. كما كنت أرى أن الخطاب الشعري كلما كان في وعاء أكبر كلما استوعب الإنسان بشكل أوسع وحمل نفسه إلى أماكن أبعد، وعلى الرغم من أن اللهجات العامية أقرب إلى الناس وأسرع في مس حاجاتهم، إلا أنها تنتخب ناسًا أخص ومساحةً أقل، لذلك كان سهلاً عليَّ أن أتخذ من الفصحى أداةً لحمل خطابي الشعري للإنسانية، الرؤى في تأسيس المشروعات - كل المشروعات -، قائمة على طرح الأسئلة والإجابة عنها، هكذا وجدت مساري. هل في القصيدة السودانية الحديثة ما يمكن اعتباره «هوية»؟ لا يمكننا أن نحمِّل القصيدة همًا اجتماعيًا ثقيلاً كمسألة الهوية، فالهوية لا يمكن بعثها وترسيخها من خلال القصيدة فقط، صحيح أن الشعر عنصر مهم في هذه المسالة طالما كانت حياة الناس في السودان مرتبطة بالشعر ارتباطًا وثيقًا كارتباط العطر بالوردة، لكن هناك عناصر عديدة بالضرورة وجودها حتى إذا تكاملت العناصر استطاع كل عنصر أن يؤدي دوره بكفاءة ومسؤولية. وعلى الرغم من ذلك فإنني أرى أن القصيدة السودانية بكل أشكالها وانواعها وشعرائها وازمانها، أدت دورها على درجة عالية وما زالت تعزز هذا الدور وتنتظر بقية العناصر في محطة شاهقة للقيام بدورها في هذا الصدد. في قولك «كل ما لي من قناديل الكلام حصدته من حصة العربي»... هل ترى أن العربية منبع حبك الأول للقصيدة، أم أنها مجرد وعاء لصوت أعمق؟ ربما في فترة ما كانت كذلك، فقد كانت حصة العربي فيما مضى، مجموعة من النشاطات الابداعية، ففيها المطالعة والتعبير والخط والرسم والتمثيل، الخطابة والإلقاء الشعري، لكن بمرور الوقت تكتشف أن الحب ليس نابعا من أنها المقرر الذي بعث فيك القصيدة وأنت تدرسه، بقدر ما هو امتنان لها لأن فيها استطعت أن تلمس مكان تكليفك بهم الشاعرية، وتعرف فيما بعد أنها واحدة من أهم أدواتك التي تحتاجها للمساهمة في الانسانية بما أنتجت من ابداع. هل تشعر أحيانًا أنك تكتب تحت وطأة المسؤولية عن «الصوت السوداني» ؟ بشكل أخص، نعم.. لابد أن تحمل الصورة الشعرية الخاصة بمجتمعك وناسك إلى أي مكان تذهب إليه لغرض الشعر، لابد أن نُخبر الناس بما لا يعرفونه عنا، كيف نحب، كيف نكره، كيف نُغني وبم نواري حزننا، ما الذي نحتمله وما الذي يُثقِل علينا وما الذي يمكن أن نموت من أجله، لكي يعرفونا، لابد أن يروا في قصيدتنا أشياء غير التي تصدرها لهم السياسة. وبشكل أوسع أشعر أنني تحت وطأة الصوت الإنساني، إن الإنسان هو محور التكليف بالشعر. في شعرك، لا يبدو الحزن ترفًا بل نَسغًا. فهل الحزن شرط الشعر، أم قدره؟ الشعر كائن التحولات الفجائية المتعددة، يملأ عليك حياتك ثم يبدع في تبديل الشروط كيف يشاء، الحزن ليس الشرط الأوحد، ثَمَّ شروط كثر، لكن الحزن أعلاها صوتًا وأشدها حرقًا، إنه الأوار الصامت الذي يختبئ في مكان ما بالجسد لا تعرفه إلا وهو يغرس مخالبه في الروح فيدميها وينزف. ماذا عن قصائدك القديمة، هل تشعر أنها لا تزال تخصّك؟ القصائد القديمة مرايا، ترى فيها قلبك فتعرف كم شخت وكبر همك، كلما أقرأ قصائدي القديمة، أدرك أنني كنت شاعراً والآن صرت أكتب الشعر، أرى جُرأتي على الشعر وصبره علي، أتمنى لو استطعت أن أحك الصدى الذي باض في الروح لأكتب شعراً في بنات المدرسة، أو لأنتقد المسؤولين وهم ينقلون محطة المواصلات العامة من قلب (السوق العربي) إلى موقف (جاكسون)، القصائد القديمة كالحبيبة التي لم تخنك ولكن تزوجت من مغترب. ظاهرة تحول كثير من الشعراء إلى كتابة الرواية، هل هي خضوع لقانون العرض والطلب؟ وهل فكرت في مجاراة التيار؟ لماذا نعتبرها تحولاً؟... ربما توسعًا في الخطاب الابداعي، وذلك أن ما لم يستطع الشاعر أن يحيطه في الشعر يمكن أن يكمله في نوع آخر من الإبداع، يسمح له بقول ما لم يستطع أن يفكر به في الشعر، لا يجب أن تكون المحاكمة للفعل وإنما للناتج من الفعل، هل الرواية التي كتبها لائقةً بكونها رواية أم لا؟ يبصر قارئك انعكاسات التأمل، السخرية، والتصوف في كثير من قصائدك، فهل ترى أن الشعر يحتاج دائمًا لمرايا أخرى؟ لو نظرت في تجربة الشعر السوداني من الخمسينات و إلى الآن فإن هذه الانعكاسات (التأمل، السخرية، التصوف) هي سمة أساسية في معظم هذه التجربة، وذلك أن الواقع السياسي والاقتصادي وفشل الدولة المستمر، بكل أشكالها يلقي بظلاله على الشعر السوداني، ويمثل صوت احتجاج ضد هذا الفشل، هذه الانعكاسات عتادهم لمواجهة الاحباط المستمر، وجيلي منهم وأنا من جيلي، لم نخترها، ولا نحتاج بعضها، لكنها التصقت بنا كالتصاق العثرة بالسقوط. شاركت في عدة مهرجانات وفعليات داخل وخارج السودان، فأيها شكلت نقطة تحول في رؤاك كشاعر؟ كلها أحدثت أثرها في التجربة، حسب زمانها ومكانها والأحداث التي صاحبتها، إنما كان للخروج الأول إلى مهرجان الشارقة 2020 طعمه الذي ما يزال عالقًا بالذاكرة، إنه التحول من الثقة بتطور مشروعك الشعري إلى تعزيز تلك الثفة بدعوة من منبر محترم مرت عليه أسماء كبيرة تركت أثرًا على منصاته، واللقيا بالأصدقاء الذين انخرطت في التواصل معهم إسفيرياً، أساتذة كنت تقرأ لهم وترى في تجاربهم ما يمكن، أن يفيدك في مشوارك، تفاعل جماهيري من السودانيين في كل مكان، مما مهد لي أن أضع شيئا من عملي بين يدي ناس لم يعرفوني إلا بالشعر، كان وما يزال كالحب الأول. دار الأجنحة بدأت كمغامرة ونضجت كمشروع ثقافي. ما اللحظة التي شعرتَ فيها أنك لم تعد شاعرًا فقط، بل صرت مسؤولًا عن حركة نشر وأصوات شعراء آخرين؟ بيمنا كنت أخوض مغامراتي الأولى في النشر، كنت أتلمس بألم معاناة الكتَّاب السودانيين في عملية النشر، فهي صعبة ومكلفة، وإن تمت العملية فإن هناك المعاناة من عدم الاهتمام بالجودة وعمليات ما بعد الطبع، مثل الاحتفاء والترويج والتوزيع، وحسب تخصصي في إدارة الأعمال، فكرت هل يمكن تأسيس مشروع معرفي يسد النواقص الماثلة في سوق النشر الحالية؟، وبناءً على ذلك عملت استبيانا سريا عن مشاكل النشر، وبواسطة هذا الاستبيان جمعت عددًا وافرًا من المعلومات وحللتها فوجدت أن تلافيها ممكن بقليل من الأفكار الجديدة وبعض الاجتهاد، على ضوء ذلك اتخذت قرار تأسيس (دار الأجنحة للطباعة والنشر والتوزيع) . لحظتها شعرت أن مسألة (إدارة المبدعين لشأنهم) التي كنت أتحدث عنها للأصدقاء الذين يشتكون من عدم الاهتمام بالمبدعين وتولي أناس من مؤسسات لا علاقة لها بالإبداع ولا الثقافة أمر المبدعين، قد حان وقت خوضها فعلياً، وأشعر أنها نجحت عند ما أنظر إلى المعرفة التي أنتجتها الدار خلال هذه السنين القليلة، وعندما أرى احتفاء الأصدقاء بها ووضع كل إمكاناتهم المعرفية تحت تصرفها واعتبارها دارًا كل المبدعين. أنا أعتبر دار الأجنحة منبراً معرفيًا هدية من جيلي لخدمة المعرفة في بلدنا. كأغلب الناشرين، هل تنحاز كناشر للرواية أكثر من الفنون الأدبية الأخرى وأولها الشعر؟ لا أبدًا، نحن في البداية كانت كل أعمالنا في الشعر، حتى خُيل للناس أننا متخصصون في الشعر، لكن بمرور الوقت أصبح هناك توازن في إنتاج الأعمال وتعدد في الموضوعات، وبحمد الله رغم ظروف بلدنا خلال السنين الأخيرة ما زلنا نعمل بأقصى طاقتنا ونعزز من وجودنا كمؤسسة رائدة وراسخة في صناعة المعرفة، ونعمل على نقل أفكار السودانيين ومعارفهم إلى أي مكان في العالم يقبل المعرفة، وجلب معارف العالم إلى مكتبات السودان.
