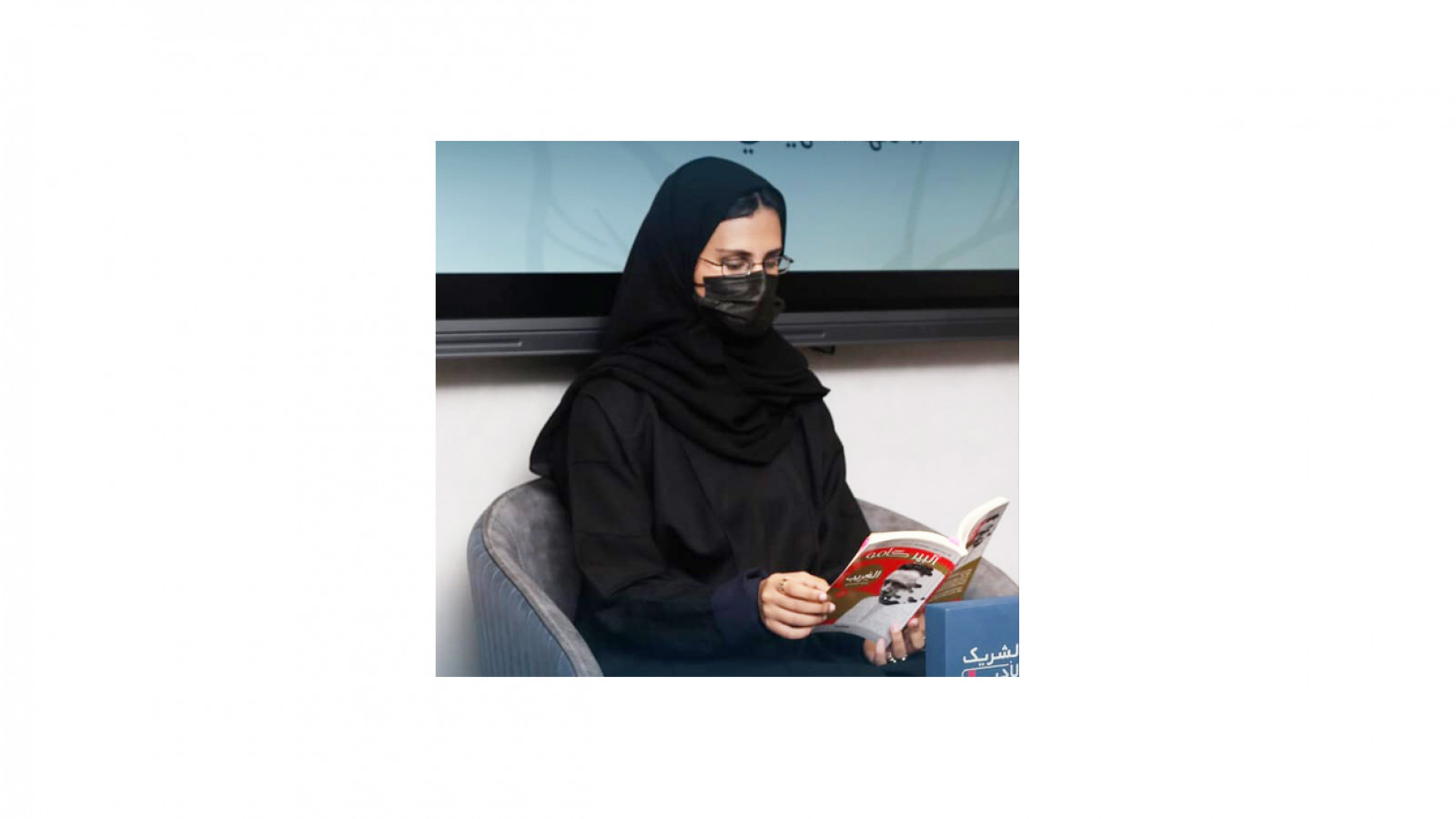
للتاريخ الإنساني نظرتان لا ثالث لهما، نظرة الشاعر الشاعرية والمرهفة والحساسة للأمور، ونظرة السلطة التي لا تنفك عن إيجاد التبريرات لأي مشروعٍ سلطوي، مثل محمد وعبد الله في الرواية، هذان الضدان اللذان تكاملا في النهاية كتاريخٍ واحد، فهما في نهاية المطاف: عيال عايد. لا مصداقية في التاريخ، حيث إنه غالبا ما يروى من منظور طفولي كمنظور محمد وعبد الله، ولا شيء ينتصر للتاريخ؛ كراوٍ يدرك أن كل ما حدث ما هو إلا مادة خام لرواية جيدة. قصة مدهشة، ممتعة، وحقيقية. رحلة أخذنا بها د. عبد الله الزماي في آلة زمن للتسعينات الميلادية، في قرية “جيم” حيث لا شيء أقسى من نظرات الناس. تتبلور لنا الحياة القروية، في أدق تفاصيلها، من سوق الأربعاء إلى قوانين سنت بصمت واتبعت وكأنها أنزلت من السماء. رواية تجلى بها تخصص د. الزماي، علم الاجتماع، فأبدع في كل سطر منها؛ ما يليق بمتخصص مثله. فقدم دراسةً ممتعة عن الحياة في ذلك الزمن، في إطار روائي شيق. من طبيعة علاقة الأطفال بالعالم، بأبويهم، علاقات النساء ببعضهن، سلوكيات أهل القرى، ممارسات الإقصاء لكل ما هو مختلف، قدسية الرجال المفروضة فرضًا والتي تتجلى لنا في تقديس كل ما يخصهم، حتى أماكنهم في المنزل، سواء كانوا غائبين أو حاضرين، فمجلس الرجال مكان محرم، وأماكن النساء فيها أمر معيب. رواية تجد فيها من كل شيء طرفا.. فلو أردت قراءتها من أي زاوية مختلفة لما أتعبك البحث و”التنبيش”. طبيعة السرد في الرواية ممتعة أيضًا، فنحن لا نقرأ أحداثًا تحدث الآن، بل ذكريات طفلين على أوراق قديمة وجدها الناقل أبو فهد في بيت اشتراه منهما، فنقلها لراويٍ لما رأى بهما من إبداع وجمالية. فالقارئ يقرأ إذن من عدة أقلام؛ محمد، والذي كثيرًا ما تتناقض كلماته مع عبد الله، وعبد الله، والذي أيضا كثيرًا ما تتناقض كلماته مع محمد، وأبو فهد؛ الذي ذكر القليل وكان قليله كافيًا، فقال في إحدى السطور إنه صدم بما قرأ من اختلافات وتنافر، فهو لم يكن ينظر لهما بوصفهما شخصين مختلفين، بل كان يرى ببساطة كيانًا واحدًا “عيال عايد” وكأنما كانت كل تلك التناقضات والاختلافات، ظاهرة لهما فقط. وفي النهاية والبداية، نقرأ لراوٍ اتجه له أبو فهد بالأوراق لنشرها، وهو من كان يرغب بكتابة رواية تاريخية، فحصل مراده دون مجهود. وكأنما يخبرنا المؤلف باختياره هذا لتعدد السرديات أن التاريخ كذلك، رؤى متنافرة، متناقضة، للحدث ذاته. وبالرغم من أن أبا فهد رأى في محمد وعبد الله كيانًا واحدًا “عيال عايد” إلا أنهما ظلا حتى النهاية ضدين لم يسعهما الاتفاق، ألم تبدأ الرواية ببيعهما للبيت في القرية؟ ونستشعر خلافًا ما ذكر نصًا، لكنه واضحٌ للأعمى. يعيدني ذلك إلى كلماتهما، أن الكبار لا يفهمون شيئًا عن الصغار، ولا يعنيهم الفهم. فلعل اختلافات بسيطة تجلت في صورة ببسي وميرندا، كانت بذرة اختلافات أكبر ظلت معلقة إلى آخر العمر. اختيار الأسماء مميز كذلك، حيث يعكس طبيعة الحياة القروية بامتياز، فمحمد وعبد الله من أكثر الأسماء شيوعًا، أليست الرغبة الأولى هي الرغبة بالانتماء كلما ضاق المكان؟ إن أغلب ممارسات البشر تصب في هذه الرغبة البسيطة، رغبة ألّا نكون الغريب والمقصى، رغبة ألّا نكون مميزين بما يكفي لتتوجه لنا أصابع الاتهام قائلة: ليس مثلنا. تبدو الرواية في أحيان كثيرة كمحاولة لإعادة تعريف الذكريات والتاريخ، ففي طريقة السرد، وفي تناقض الأحداث، وفي حقيقة أن كل ما ذكر مجرد ذكريات منقولة ورقيًا، لا منطوقة شفيهًا، الكثير. شدتني كذلك بداية الرواية، محمد خلف المقود، وهو من يتحدث. “محمد خلف المقود، وعبد الله إلى جانبه.” سطر بسيط رسم لنا وبوضوح طبيعة علاقتهم. كما أبهرتني حقيقة أن فصل الختام لذكريات محمد وعبد الله ينتهي بحديث محمد وبكلماته “كنت أتصور أنه ليست البيوت وحدها من تمتلك مثل هذا الخنبش، بل حتى النفوس البشرية، بل ربما هي بحاجة أمس من البيوت إليه، ليرمي فيها الإنسان كل ما قد يحتاج إليه، مما يمر به من أحداث وحكايات وشخوص، ويلقى فيه ما لديه من ذكريات قديمة، لا تخلو هي الأخرى من أفاعيها وثعابينها السامة والقاتلة ربما، ومن يدري ربما تتصدى لها يومًا عصا النسيان فتمحوها وتبطل كيدها وشرها.” فبالرغم من أن عدد الكلمات بين محمد وعبد الله شبه متقارب، وبالرغم من أننا قرأنا ذكريات الاثنين، إلا أنني شعرت أن اليد العليا في كل هذه الحكايات كانت لمحمد. وكأنما رُسم قدرهما باسميهما، فمحمد هو اسم نبي الله المختار وآخر الأنبياء والمرسلين، بينما عبد الله هو جميع من على الأرض. لفت انتباهي أيضًا أول سطرٍ لكليهما، وأول وعي، وأول ذكرى. فبينما كانت أول ذكرى لمحمد هي وعيه بمحيطه ومجتمعه والطبقية الاجتماعية التي شهدها حتى في أتفه الأمور، كانت أول ذكرى لعبد الله هي وعيه بذكريات والدته وقصصها عن حياتها قبل زواجها بوالده. فهل كانت هذه الذكريات، وهذان الوعيان المختلفان كليًا، هما ما وجه مسارهما في الحياة؟ تنتهي الرواية بلفتةٍ عبقرية وهو سؤال بسيط من الراوي: “وربما أيضًا لولا ما قمنا به من إضافة لتحولت هذه الرواية إلى مجرد ذكريات اطفال بسيطة لأحداث عادية، من يدري؟” وهذا هو حال التاريخ، وحال الذكريات، وحال الماضي. مجرد روايات، بإضافات عديدة، وتنقيح أكثر.
