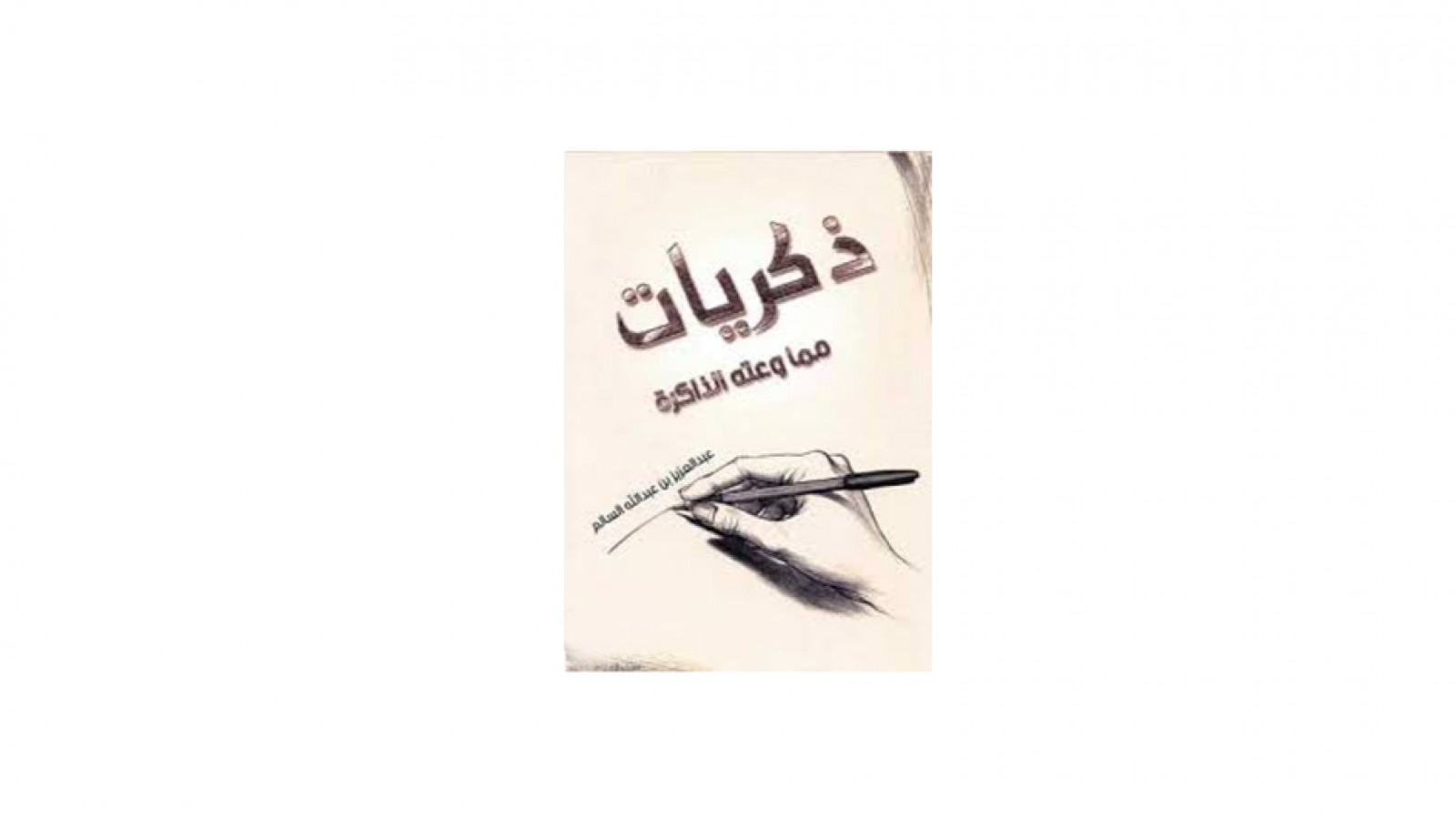
كتب السالم هذه السيرة بعد أن شارف على الثمانين، ورغم أن كلماته تتدفق على الصفحات بسلاسة ورُقي إلا أنه - وكما قال كاتبه - ليس سيرة ذاتية متكاملة، وقد تعذر الكاتب بوهن الذاكرة، ولكنني أظن أن ذلك كان تداعيا طبيعيا لطريقة الكاتب المعروفة عنه في التأمل العقلي والغوص وراء الأفكار، ويبرز من خلال الكتابة اهتماماته التربوية والأخلاقية، وأحيانا ينحو نحو الوعظ الرقيق. ولذا فإن القارئ الذي لم يكن من الجيل الذي تابع حضوره الثقافي من خلال الصحافة السعودية سيجد فراغات كثيرة في سيرته لا ترضى فضول جمهور كتاباته، ولا شك أن مثابرة الكاتب على صفحته الأسبوعية في جريدة الرياض حوالي عقدين من الزمان، وما كانت تتمتع به من الحيوية المثيرة للعقول، والاسم الرمزي مسلم عبدالله المسلم الذي يختفي خلفه الكاتب، ثم تهامس الباحثين عن الاسم الحقيقي للكاتب الذي يشغل موقعا مرموقا في الدولة، والذي لا تقترن صورته بما يكتب، وذلك كله كان يستثير قدرا كبيرا من الفضول. اختار الكاتب أن يسبق مقدمة الكتاب بمدخل، تحدث فيه عن السير الذاتية التي كثرت بين مفكري العالم العربي تفاعلا مع نتاج الٱداب الأوروبية من السيرة، وهو يحمد ما يميز أغلب السير العربية من ابتعاد عن التكلف والشطط، مما يقود إلى السمو الأخلاقي والارتقاء بالذوق العام، وينتقد ما أنجر إليه بعض الكتاب العرب مثل مؤلف «الخبز الحافي» من الكشف عما أمر الله بستره، مما يُخجل، ولا يرتقي بالذوق ولا بالأخلاق، فما هو السمو الذي تراه في رجل تعرى من الثياب وسار بين الناس عارضا عوراته؟ والقارئ إذ يرافق كاتبه لن يعرف اسم القرية التى ولد فيها الرجل، لكنه يعرف أنها قرية نجدية، وأنها كانت ذات ماض مجيد ولعلها كانت عاصمة يوما ما، ولكن حسن الطالع رافق الكاتب من يوم مولده، إذ ولد في عام التوحيد السياسي ولذا فإن الكاتب متماه مع الوطن، لا يميل إلى أن يكون ابن هذه القرية أو تلك أو ابن هذه القبيلة أو تلك فهو مواطن عابر انتماؤه متشعب خلال كافة أرجاء الوطن، يشبه كل مواطنيه، شكلا وعملا ومسيرة، ورغم ما في هذا التعبير عن المواطنة من رومانسية، فقد فتح لي نافذة على الشجن، إذ عندما كنت طالبا في الابتدائية كان نشيد الصباح في المدرسة وفي الحفلات «بلاد العرب أوطاني… من الشام لبغدان… ومن نجدٍ إلى يمنٍ .. إلى مصر.. فتطوان… «، و عندما انتقلت إلى المدرسة المتوسطة توسعت حدود الوطن الذي عبرت عنه قصيدة يتكرر انشادها في الإذاعة المدرسية أسبوعيا أو يوميا.. « و كلما ذُكر اسم الله في بلدٍ… عددت أرجاءه من لب أوطاني». انتقل من القرية إلى المدينة حيث والده، كان والده مهتما بتعليمه في المدرسة بعد أن درس في كُتاب القرية، وقد دخل المدرسة رغم أن أحد أصدقاء والده عيره بأنه يأخذ بابنه إلى المفسدة. لكن الطفل كان الأول دائما على فصله، مما أهله ليكون العريف المسؤول عن الإنضباط في غيبة الأستاذ، وكان في طريقه للحصول على الشهادة الإبتدائية ولكنه ترك المدرسة في السنة الخامسة، فقد دخل المدرس يوما فلم يجد الانضباط المطلوب، وكان هذا متوقعا فقد كانوا عائدين للتو من الفسحة، طلب الأستاذ منه أن يكتب أسماء المشاغبين، فقال العريف: كل الطلبة شاركوا، فناله توبيخ وعقاب بدني بالضرب على يده، غادر المدرسة رافضا العودة مرة أخرى، ولم يجبره أبوه على تغيير قراره، وكان ذلك غريبا فالأب كان مثل غيره يعتمد القسوة الشديدة طريقةً مًثلى في التربية، مثلا ضحكة طفله في مجلس الرجال تعرضه للعقوبات الجسدية العنيفة، ولكنه في هذا الموقف تسامح مع قرار ابنه. كان الوالد ذا شخصيتين متناقضتين، فهو شديد الصرامة في البيت، لكنه رجل لطيف ودود فكه خارج البيت، وككل رجال المجتمع النجدي حريص على التربية الدينية، الصلاة في المسجد، و اليقظة لصلاة الفجر، و قيام الليل مع كافة أفراد الأسرة، كان مجتمع نجد كما يقول الكاتب قريبا من مجتمع الصحابة و خاصة في القرية. المؤلف مولع بالتربية و التأريخ الاجتماعى، نجده يرسم مشهد القرية و مشهد المدينة، و تأثير المكان و الزمان في الناس ببراعة الخبير، كما يتابع طرق التربية التقليدية و التربية الحديثة، حسنات كل منهما و عيوبه، و تجليات كل منهما في حياة الأجيال. و هنا نرى أن مجتمع المسجد الذي اجتذبه لم يكن كذلك لبعض زملائه، فعدم الترفق في إيقاظ الأطفال لصلاة الفجر، وإجبارهم على السير للمسجد في الليالي الباردة جعل أحدهم يزهد في صلاة الجماعة عندما غادر الطفولة. انقطع الطفل عن المدرسة ولكنه عاد إلى مدرسة أخرى، وتعرض لتجربة مهينة أخرى، وإن لم نعرف أين كانت هذه المدرسة، وقد فهمنا من السياق أنها كانت مدرسة داخلية، أي أنها كانت توفر المبيت، كما ذكر أنه تقدم للوظيفة بالشهادة الابتدائية، وكانت الوظيفة هي مدرس لطلاب المرحلة الإبتدائية، ولكن مواهبه الكتابية التى أهله لها شغفه المبكر بالقراءة والكتب جعلته مسؤولا عن كتابة الوثائق الرسمية، الأمر الذي رقاه ليعمل في وظيفة في إدارة التعليم كان قدم حُرم منها سابقا، ثم التحق بالمعهد العلمي وابتعث للدراسة في كلية ٱداب القاهرة، ولتفوقه كان مهتما بإكمال تعليمه العالي، ولكنه التحق بوظيفة حكومية وكان يأمل أن تفتح له باب الإبتعاث للحصول على الدكتوراة، لكن الوظيفة استغرقته ولم تحل بينه وبين ما يحب. فهمنا أنه كان في وظيفة مرموقة ذات وجاهة اجتماعية رفيعة، ولكن الرجل كان ميالا للعزلة لكي يتفرغ للكتابة والقراءة، وظل شغوفا بأن يرتفع في مقام الكتابة والفكر إلى أرفع مقام ، مفضلا ذلك عن أي مقام رفيع تتيحه له وظيفته المرموقة، بل إنه حين يقارن نفسه بمن لم يواصل طريق التعليم، يجد نفسه أميل للتفرغ للقراءة والكتابة عن الاشتغال بتحصيل الشهادات والارتقاء الوظيفي، رغم أنه نجح في الأمرين معا، ولكنه فيما يشبه الاستدراك يتحدث عن بعض مجايليه الذين اكتفوا من التعليم بالكتابة والقراءة ، ولكن الحياة على مستوى المادة وضعتهم في مقام الحاجة للمساعدة، ويذكر أنه يشعر نحوهم بالكثير من المسؤولية التى تدفعه للقيام على بعض شؤونهم، ولكنه يخشى عليهم وعلى أمثالهم من أن تتسلل إليهم أفكار شيوعية فينخدعوا كما انخدع غيرهم ويصبحوا مصدر قلاقل للمجتمع، ولذا فإنه يدعو إلى معالجة وضعهم القلق، فبحمايتهم من الحاجة يحمي المجتمع نفسه من القلاقل الفكرية والتوتر الإجتماعي. وهو أمر يفترض أن يقوم المجتمع التراحمي به في كل الأحوال. وهذا الموقف طبيعي لمن بنى وعيه خلال ستينيات القرن الماضي الذي كانت الشيوعية تحتل مساحة كبيرة فيه، قبل انحسارها في نهاية القرن. من التجارب المبكرة التى تعرض لها، وحفزت عقله على التفكير الإيجابي ، تجربة الحياة في بيت فيه جَوارٍ، وقد كان الرق في ذلك الزمن مشروعا، إحدى الجواري كانت تتمتع بصوت جميل، تغني غناء حزينا جميلا يقطع نياط القلوب، ولكن ذلك فقط عندما تنفرد بوحدتها، فهي لم تُخلق لتُمتع الٱخرين، وكانت شَموخَةً حريصةً على كرامتها، وإذ يقارنها بجارية أخرى كانت متبذلة، فقد رضيت بوضعها في أدنى المراتب، وأرادت بتبذلها أن تحقق بعض المزايا، خشى والده على أولاده منها، فزوجها أحد عبيده، ولكنه اشترط أن يكون أولادهما عبيدا له، وهذا ما استوقف الطفل كثيرا، ما مشروعية ذلك على المستوى الأخلاقي والشرعي؟ وهو يحمد الله على قرار عتق العبيد، وعلى أن هذين العبدين لم ينجبا حتى تتكرر في نسلهما تجربة العبودية. ولعل هذه الأحاسيس المريرة هي ما حفز عضلات الفكر في عقله وأورثه مهارات التأمل والتفكر. يذكر السالم والدته وأخته غير الشقيقة بالكثير من الحب و الحنان، وقد فاضت عواطفه نحو أخته التى توفيت في عمر مبكر، إذ كانت تنافس أمه في الحنان و توفير المحضن الدافئ له ولأخويه، وكما غرف من كرمهما العاطفي وإمكاناتهما المادية الضئيلة فإنه تناول المرأة ووضعها في المجتمع سابقا بالكثير من التعاطف والنقد، نساء المجتمع كن سياج الأمان للأبناء والأزواج والعائلات الكبيرة ، ولفت نظري أن مسجد قريتهم كان يجتذب أغلب النساء لصلاة الفجر فيحتشدن في الصفوف الخلفية، حيث يسود الظلام وخاصة حين يُطفأ المصباح مباشرة بعد التسليمتين. ولكنهن أكثر من يعاني من قسوة الزوج، ومن كثرة أعباء التربية ومشاغل البيت، ومع ذلك لا يجلسن إلى المائدة مع ذكور الأسرة، وإذا كان هناك ضيفان فإن الكرم المعتاد يؤثر الضيوف ثم الذكور بخير ما في الوليمة، وفي بعض الأحوال لا يبقى للنساء إلا الفتات. ورغم ذلك فقد كن راضيات، قائماتٍ على تنفيذ سياسات الأزواج داخل البيت، وقد aيترتب على حمايتهن الأبناء من قسوة الأزواج أن ينالهن نصيبٌ من التعنيف. يذكر أنه عندما بلغ مبلغ الزواج اهتمت العائلة وخاصة نساء أسرته بتزويجه، كان يريد فتاة نالت حظا من الثقافة والتعليم ليتحقق له الانسجام، ومضت أمه تستعرض مزايا المرشحات للزواج، ولكنه أفصح لها عن المواصفات التي يريدها فعلقت (خذ الشوشة حتى تجيك المنقوشة)، وهذا استفز حسه الإنساني والأخلاقي الذي لا يقبل مثل ذلك، فإن قبل المجتمع أن يتمتع بزوجة مؤقتا حتى يجد الزوجة المناسبة فإنه لن يقبل، فإن احترامه لكرامة المرأة، وحرصه على توفير الانسجام للأسرة والأبناء تمنعه من قبول عرض كهذا. توافرت في مجتمع اليوم الكثير من وسائل الترفيه إلا أن المجتمع القديم لم يكن محروما، جذبني ما ذكره من جلوس الرجال في الشارع، يجلسون في المشراق شتاءً حتى يحظوا بالدفء ثم ينتقلون حسب الظل في الصيف هربا من الحر، وهناك تجري الأحاديث بينهم و يضفي عليها الخيال ما يزيدها امتاعا، ويسمعها الأولاد فتؤنسهم، الأحاديث فكهة وجذابة، فيها القصة والخاطرة كأنها مسلسل من مسلسلات التلفاز، يتحدث الرجال بينما يفتلون الحبال من ليف النخيل. فهم منتجون حتى في وقت الترويح عن النفس. ولا شك أن قارئ هذا الكتاب سيشعر بما شعرت به، فقد شرب شَربِةً هنيئة لم تروه بل ربما زادته عطشا. فهو ينتظر المزيد.
