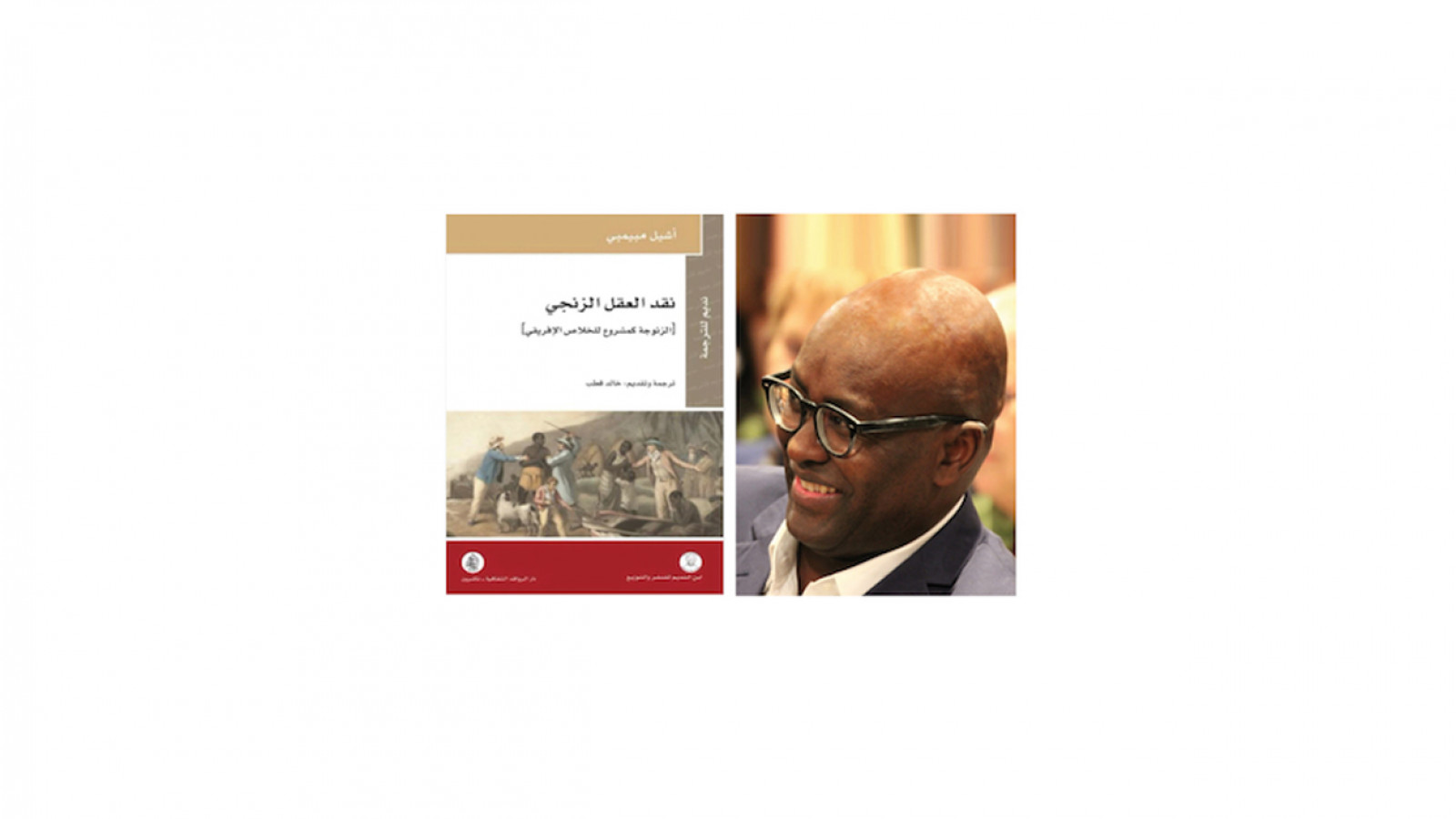
في كتابه “نقد العقل الزنجي” لا يكتب أشيل مبيمبي نصًا في الهوية بقدر ما يكتب نصًا في مسرح الهوية: كيف صارت “الزنوجة” فكرة تُنتج وتُستهلك وتُدار داخل سوق عالمي للمعنى، وكيف تحوّلت البشرة من كونها أثرًا جسديًا إلى كونها علامة ثقافية تُستدعى كلما احتاج النظام الحديث إلى عدوٍّ يؤسس به ذاته. الكتاب، بهذا المعنى، ليس دفاعًا رومانسيًا عن السود، ولا بيانًا شعاراتيًا ضد الغرب، بل محاولة لفكّ الشبكة: شبكة الاسم حين يصير قدرًا، والتاريخ حين يصير قيدًا، والإنسان حين يُعاد تعريفه من خارج إنسانيته. لكن ما الذي يفعله مبيمبي بدقة؟ إنه يحاول أن يقول لنا: إن “الزنجي” لم يكن حقيقة طبيعية بقدر ما كان اختراعًا معرفيًا. اختراعٌ خُلق في لحظة الحداثة الأوروبية حين احتاجت أوروبا إلى مرآة ترى فيها تفوقها، فصنعت الآخر بوصفه نقصًا. هنا يتحول “الزنجي” إلى وظيفة: وظيفة في الاقتصاد (العبد)، وفي الفلسفة (الإنسان الناقص)، وفي الأخلاق (المبرر الاستعماري)، وفي الخيال (الكائن الغرائبي). وهذه واحدة من أقوى أفكار الكتاب: أن العنصرية ليست مجرد كراهية فردية، بل نظام معنى يشتغل مثل اللغة: ينتج صورًا وقواعد وتوقعات، ثم يقنعنا أن هذه القواعد “طبيعية”. غير أن النقد البنّاء يبدأ عندما نسأل: هل ينجح مبيمبي في تفكيك هذا الاختراع دون أن يقع في إعادة إنتاجه؟ هنا تبرز أول مفارقة في الكتاب: حين تقول “العقل الزنجي”، أنت توحي بأن ثمة عقلًا خاصًا مرتبطًا بسلالة أو لون، بينما يريد المؤلف أصلًا أن يهدم فكرة الربط بين العقل واللون. صحيح أنه يستخدم العبارة بوصفها مجازًا نقديًا لا جوهرًا بيولوجيًا، لكن المجاز نفسه خطير؛ لأنه قد يفتح الباب لسوء الفهم: كأننا انتقلنا من عنصرية تُقصي السود إلى خطابٍ يثبت لهم خصوصية عقلية قد تُقرأ بوصفها قفصًا جديدًا. وهذا مأزق المفاهيم الكبرى: قد تهزم عدوّها في الحجة، لكنها تستبقيه في اللفظ. يشتغل مبيمبي أيضًا على فكرة ثانية عميقة: أن “الزنجي” لم يعد محصورًا في الشخص الأسود وحده، بل صار نموذجًا قابلًا للتعميم داخل الرأسمالية المتأخرة؛ أي أن العالم المعاصر ينتج حالات “تزنّج” رمزي: هشاشة، إقصاء، تهميش، قابلية للاستغلال. من هنا يتجاوز الكتاب حدود العرق إلى تحليل آليات السوق الحديثة. وهذه فكرة ذكية لأنها توسّع السؤال: ليست المشكلة في لون البشرة وحده، بل في منطق تحويل البشر إلى مواد. لكن البناء هنا يحتاج حذرًا: حين نعمّم “الزنوجة” لتصبح استعارة لكل مظلوم، نخاطر بأن نخسر خصوصية التجربة السوداء التاريخية، وأن نجعل الألم قابلًا للتدوير مثل أي سلعة فكرية. إن تحويل المعاناة إلى استعارة، حتى لو كان بنية تحليلية، قد ينتهي إلى تمييع ذاكرة الرقّ والاستعمار بدل إنصافها. أما الفكرة الثالثة فهي الأكثر إثارة عند مبيمبي: أن الحداثة الأوروبية لم تصنع تقدمها وحده بالعلم والعقل، بل صنعته أيضًا عبر عنف تأسيسي: الاسترقاق والاستعمار وتقسيم البشر إلى مراتب. هنا يجرّ الكتاب الحداثة من شعرها، ويقول لها: لا تتباهَي بالعقل وحده؛ ففي الظل كانت هناك آلة. وهذا تفكيك ضروري، لكنه يستدعي نقدًا إضافيًا: مبيمبي في لحظات كثيرة يقدّم أوروبا بوصفها مركز الجريمة ومركز السرد معًا؛ أي أننا نظل ندور داخل مركزيتها حتى ونحن نفضحها. نقد المركز لا يكفي إن بقي المركز هو الذي يحدد حتى شكل النقد. النقد البنّاء يطالب بخطوة أبعد: كيف نكتب تاريخ الإنسان خارج ثنائية أوروبا/ضحيتها؟ كيف نجعل الذات غير الأوروبية منتجة للمعنى لا مجرد رد فعل؟ وهنا تظهر نقطة حساسة في الكتاب: إن مبيمبي، وهو يهاجم “الهوية المغلقة”، يقترب من نقد “الزنوجة” بوصفها سياسة مغلقة أيضًا إذا تحولت إلى تعصب أو نقاء. وهذه جرأة تحسب له؛ لأنه يرفض أن تكون الهوية سجنًا حتى لو كانت هوية الجرح. لكنه أحيانًا يقسو على خطاب التحرر حين يحمّله مسؤولية أخطائه في تمثيل نفسه، دون أن يمنح سياق القهر حقه الكامل. فالهوية المغلقة ليست دائمًا اختيارًا حرًا؛ قد تكون في بعض الحالات ردّة فعل دفاعية. ومع ذلك يبقى تنبيه مبيمبي مهمًا: لا تتحول مقاومة الاستعمار إلى استعمار من نوع آخر داخل النفس. أكثر ما يميز الكتاب هو أنه يشتغل على “الزنجي” كـ علامة قبل أن يشتغل عليه كجسد. وهذه مقاربة قريبة من الحس الغذامي في قراءة الثقافة بوصفها نظامًا ينتج الرموز ويخفي سلطته خلف جمالياته. فالمسألة عند مبيمبي ليست لونًا فحسب، بل “سيمياء” اللون: كيف صار الأسود مرادفًا للبدائي، وكيف صارت إفريقيا مرادفًا للفوضى، وكيف صار الغرب مرادفًا للإنقاذ. لكن نقدًا بنّاءً هنا يمكن أن يقول: الكتاب مدهش في تحليل إنتاج الصورة، لكنه أقل تفصيلًا في تفكيك كيف تُستعاد الصورة اليوم عبر الإعلام الرقمي وصناعة الترفيه. نحن في زمن تعيد فيه المنصات تشكيل العنصرية بطرق أكثر نعومة: تمثيل سطحي، تنميط مبتسم، “تنوع” يُستخدم كديكور. كان يمكن للكتاب أن يربط أفكاره الكبرى بهذه الآليات الجديدة بوضوح أكبر. ثم تأتي الفكرة الرابعة: الإنسان والمستقبل. مبيمبي لا يريد أن ينتهي إلى خطاب ضحية دائم، بل يبحث عن أفق إنساني يتجاوز العرق دون أن يمسح أثره. وهنا يُحسب له أنه لا يقترح خلاصًا أخلاقيًا ساذجًا، بل يطلب إعادة تعريف “الإنسان” على قاعدة جديدة: أن لا يكون الإنسان امتيازًا تمنحه حضارة وتسحبه أخرى. لكن هذا الطموح يصطدم بسؤال عملي: كيف نترجم هذه الفلسفة إلى سياسات وعدالة وذاكرة؟ الكتاب فلسفي أكثر من كونه برنامجًا سياسيًا، وهذا مقبول، لكنه يترك القارئ أحيانًا في حالة نشوة فكرية بلا أدوات تطبيقية. والسؤال الذي ينبغي أن نختم به، بأسلوب ثقافي نقدي: هل “العقل الزنجي” هو عقل الزنجي فعلًا أم عقل العالم وهو يصنع زنجيّه؟ مبيمبي يجيب ضمنًا: هو عقل الحداثة حين احتاجت إلى “آخر” لتثبت ذاتها. وهذه إجابة قوية، لكنها تضع مسؤولية البناء على القارئ أيضًا: أن يتحرر من الرغبة في هوية جاهزة، ومن الغضب الذي يتحول إلى تعريف، ومن التاريخ حين يصبح قدرًا مغلقًا. في النهاية، قيمة الكتاب الكبرى ليست في أنه يمنح السود تعريفًا جديدًا، بل في أنه يكشف لنا كيف تعمل الثقافة حين تخلق تعريفًا من الأصل. أما نقده البنّاء فهو أن هذا الكشف يحتاج دائمًا إلى يقظة لغوية: ألا نكسر القيد بمطرقة تصنع قيدًا جديدًا، وألا نخرج من المركزية ونحن نحملها في أسمائنا. التحرر لا يكون فقط من الاستعمار، بل من منطقه الذي قد يسكننا دون أن نشعر.
