في مواجهة العاصفة الصامتة..
رحلة استقصائية في تحديات الصحة النفسية بالمملكة العربية السعودية.
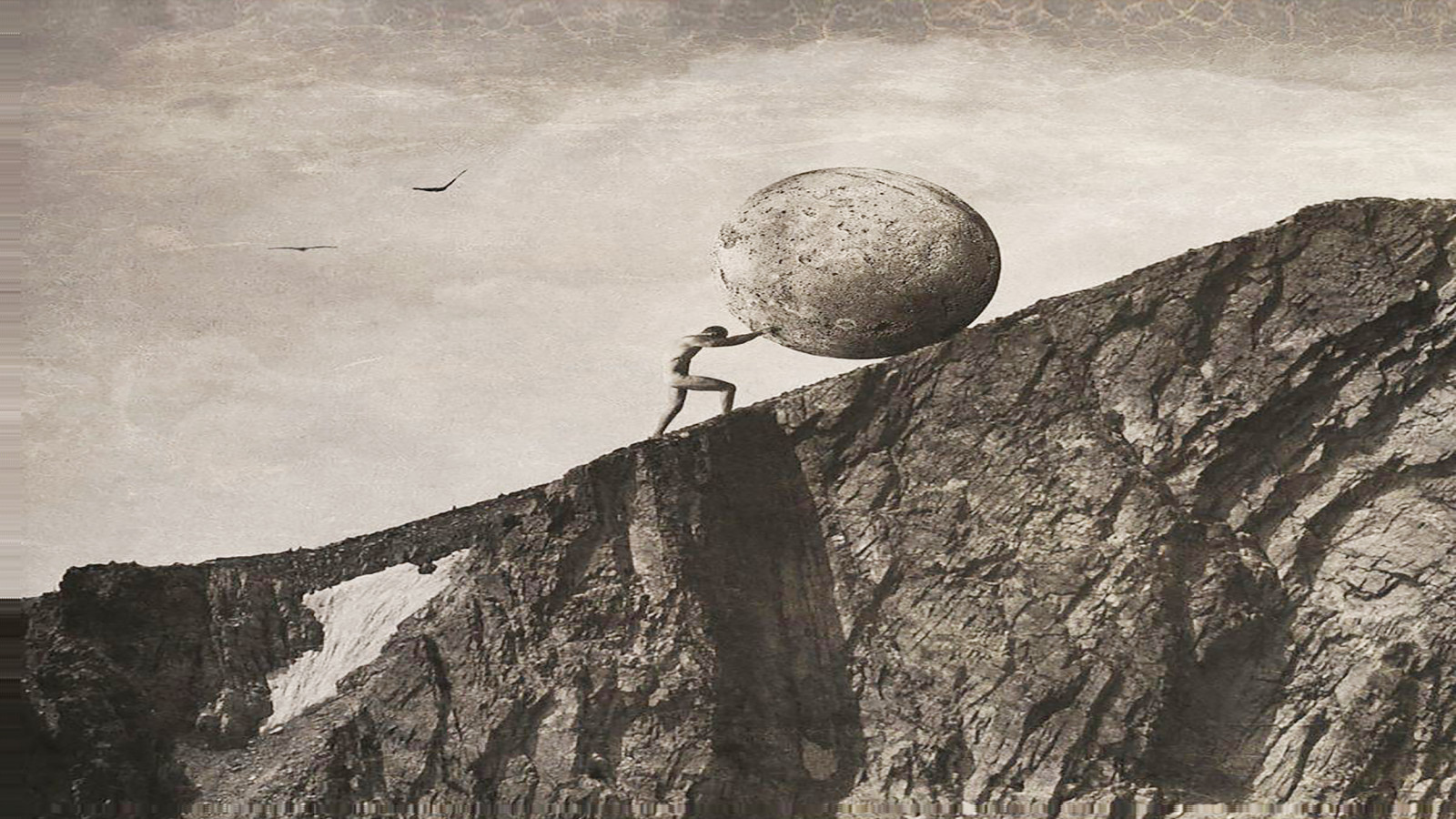
مقدمة: أزمة الصحة النفسية في عالم اليوم يبدو أن العالم يواجه أزمة متصاعدة في مجال الصحة النفسية، حيث تتسارع معدلات الاضطرابات النفسية وتتسع الفجوة بين الحاجة المتزايدة للرعاية والموارد المتاحة. تؤكد أحدث الإحصاءات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO) أن أكثر من مليار شخص على مستوى العالم يعيشون مع اضطراب نفسي، مما يجعل الصحة النفسية واحدة من أبرز القضايا الصحية التي تتطلب اهتماماً عاجلاً وفعّالاً. وفي المملكة العربية السعودية، تصل نسبــة انتشار الاضطرابات النفسيــــة مدى الحيــاة إلى 34.2 %، مع حقيقة مؤلمة تتمثل في أن 86.1 % من المصابين لا يتلقون أي علاج. هذا التقرير يرنو إلى تسليط الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه قطاع الطب النفسي والمرضى النفسيين، مع التركيز على الأبعاد العالمية والإقليمية في العالم العربي والسعودية، مستنداً إلى أحدث الإحصائيات والتقارير البحثية. الفصل الأول: التحديات الاجتماعية والثقافية الوصمة الاجتماعية: جدار الصمت العازل من بين التحديات الاجتماعية والثقافية التي تعيق طلب المساعدة النفسية، تبرز الوصمة الاجتماعية (Stigma) كأكبر عائق يواجه المرضى. لا تزال العقول تقيم المرض النفسي على أنه ضعف شخصي أو عيب أخلاقي، فتدفع بذلك الكثيرين إلى إخفاء معاناتهم خوفاً من التمييز والنظرة السلبية. دراسة حديثة شملت 16 دولة عربية كشفت أن 26.5 % من الأفراد يحملون مواقف سلبية تجاه المصابين بأمراض نفسية، مع تفاقم المشكلة في العديد من المجتمعات العربية حيث لا يلجأ أكثر من 60 % من المرضى إلى العلاج بسبب الخوف أو الجهل. أما في السعودية، فقد بلغ انتشار الاكتئاب الشديد 2.5 % بين النساء و1.4 % بين الرجال. في هذا السياق، جاء التحليل التحذيري: “الوصمة والعار (Stigma): هذا هو أكبر تحدي على الإطلاق. لا يزال المرض النفسي محاطاً بالخوف والجهل والخرافات، مما يؤدي إلى التردد في طلب المساعدة.” ويشير فهد الربيش، أخصائي نفسي وماجستير في علم النفس الإكلينيكي، إلى أن الوصمة الاجتماعية تمنع العديد من الشباب من طلب الاستشارة: “الوصمة الاجتماعية سواء من الأسرة أو الأقران تمنع العديد من الشباب من طلب الاستشارة. نلمس هذا بوضوح من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يكون التفاعل على الصفحات العامة للمختصين النفسيين ضعيفاً، بينما تكون المراسلات الخاصة كبيرة جداً.” نقص الوعي: عائق مزدوج يحول دون التشخيص والعلاج يرتبط نقص الوعي ارتباطاً وثيقاً بالوصمة الاجتماعية، مما يؤدي إلى تأخر التشخيص وتفاقم الحالة. وقد أظهرت الدراسة العربية نفسها أن 31.7 % من المشاركين يمتلكون معرفة ضعيفة بالصحة النفسية، وأن 28.0 % يحملون مواقف سلبية تجاه فكرة طلب المساعدة المتخصصة. في السعودية، يزداد الأمر صعوبة مع ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب إلى 26.2 % بشكل عام، وتتضاعف بين الشباب والطلاب، حيث تصل معدلات الاكتئاب إلى 81.5 % والقلق إلى 63.6 % بين الطلاب الجامعيين. هذا النقص في المعرفة يمنع الأفراد وعائلاتهم من التعرف على الأعراض، مما يؤدي إلى تفاقم الحالات وزيادة صعوبة علاجها. وتؤكد عائشة الزكري، أخصائية نفسية، أن اضطرابات الصحة النفسية لدى الشباب تتقاطع مع عوامل متعددة: “ منها: ضغط الأداء الدراسي والمهني، التوقعات الأسرية والمجتمعية، العزلة الاجتماعية، والتنمر. كما تؤثر عوامل اقتصادية كالبطالة والضغوط المالية.” العوامل الثقافية والدينية: بين الموروثات والمعتقدات في بعض الثقافات، وخصوصاً في العالم العربي، تُفسر الأعراض النفسية بأنها نابعة من أسباب خارقة مثل السحر أو العين، بدلاً من كونها حالة طبية. وقد أظهرت الأبحاث ارتباط الإيمان بهذه الأسباب بمواقف أكثر سلبية تجاه طلب المساعدة النفسية، مما يدفع البعض إلى اللجوء إلى ممارسات غير مثبتة علمياً قد تضر أحياناً. هنا يطرح السؤال: كيف يمكن مواجهة الوصمة الاجتماعية في المجتمع السعودي بطرق عملية؟ وهل هناك مبادرات أو حملات تثقيفية وإعلامية في هذا المجال؟ آراء الخبراء: بين الواقع والمأمول يقول الدكتور محمد الحامد، استشاري أول الطب النفسي ومدير عام مركز خبراء النفس الطبي : “الوصمة الاجتماعية تجاه المرض النفسي هي أمر متوقع، لا سيما في المجتمعات المحافظة التي تتناول المرض النفسي كنقيصة وعيب في الشخصية وكضعف في الجانب الإيماني والروحاني لدى المريض. وعلى الرغم من خطأ هذا المفهوم، إلا أنه أصبح معتقداً راسخاً لدى شريحة كبيرة من المجتمع بسبب المكون الثقافي، وتغذيته من قبل فئة تتاجر في العلاج بالرقية ومكملاتها من زيوت ومياه، ألبست لباس القدسية لتعمل عملاً سحرياً على مستوى الفكر الشعبي دون وجود إثباتات علمية.” ويضيف: “هل الخلل في نقص التوعية الصحية من قبل المختصين أم في كثافة الجرعة المضادة التي يروج لها دعاة العلاج الروحاني؟ الواقع يبين ضعفاً كبيراً في الوعي المجتمعي بالمرض النفسي ومسبباته وعلاجه.” ويشير إلى مسمى “طب نفسي” قائلاً: “مصطلح طب نفسي يوحي بلبس وغموض حول النفس، ما يفتح الباب لتأويلات متعددة تخرج عن الإطار الطبي، وهذا يعيق تطوير المجال ويزيد الوصمة. ربما يتطلب الأمر إعادة صياغة المصطلحات، كما حدث في اليابان وبعض الولايات الأمريكية، حيث تغيرت مسميات الأمراض ذات الوصمة العالية مثل الفصام.” وعن جهود التوعية، ترى تغريد إبراهيم الطاسان، أخصائية اجتماعية: “الوصمة المجتمعية هي الأثر السلبي الذي قد ينسف أي خطة علاجية مهما كانت محكمة. لذلك، لابد من العمل على التقليل من هذا الأثر من خلال حملات توعوية إعلامية بمشاركة مؤثرين من خلفيات متنوعة، دمج موضوعات الصحة النفسية ضمن المناهج الدراسية والإعلام الرسمي، وإشراك مرضى متعافين في سرد قصصهم لتغيير التصورات.” فيما تضيف عائشة علي حجازي، أستاذ علم النفس الإكلينيكي: “ولله الحمد، الوصمة الاجتماعية قلت إلى حد كبير بعد انتشار الوعي، خاصة مع الأنشطة والمبادرات التي توضح أهمية التعامل مع الاضطرابات النفسية في المدارس والجامعات والقطاعات الصحية.” ويؤكد مازن ركيني، الشريك المؤسس لتطبيق لبيه للاستشارات النفسية: “في العالم العربي، هناك 60 مليون يحتاجون علاج نفسي، لكن فقط 5% يطلبون العلاج بسبب عدم الوعي الكافي وعدم الإدراك لأهمية مراجعة المختص.” حول كفاية المبادرات التوعوية الحالية، تقول تغريد الطاسان: “المبادرات كثيرة وفعالة، لكنها لا تكفي ما لم تتطور أدواتها ومحتواها بما يتماشى مع المتغيرات. مبادرات ‘الرعاية النفسية عن بعد’ إيجابية لكنها لا تكفي لتغيير راسخ ثقافي. المطلوب إنشاء مؤشرات أداء تقيس تغير المواقف، نسب طلب المساعدة، وانخفاض الانقطاع عن العلاج.” أما الدكتور محمد الحامد، فيرى أن الجهود التوعوية حتى الآن كانت فردية وبحاجة إلى تنسيق أكبر: “بدأت جهود جميلة من اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، لكن هناك ضعف في ثبات الإيقاع وعدم خلق بيئة جماعية وطنية تشارك فيها كافة المختصين. نأمل أن تصبح التوعية واجباً وطنياً يتبناه الجميع، وخاصة المرضى الذين مروا بتجارب إيجابية، لكنهم محاصرون خلف قضبان الوصمة.” ويشير المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية إلى أن تظافر الجهود بين مختلف القطاعات سيكون له أثر أكبر في نشر الوعي، ويمكن قياس النجاح عبر مؤشرات مثل إدراك أهمية الصحة النفسية وتقبل المرضى بدون وصمة. دور المؤسسات الدينية والثقافية: شراكات من أجل الوعي تلعب المؤسسات الدينية دوراً مهماً وفعالاً في رفع الوعي الصحي النفسي، خاصة إذا كانت هناك شراكات مع هيئة كبار العلماء ووزارة الشؤون الإسلامية. ويضيف طلال الجفناوي: “شهدنا اهتمام المؤسسات والجامعات والهيئات بتقديم دورات ومحاضرات للتوعية في الصحة النفسية، وشاركت شخصياً في العديد منها.” لكن الدكتور محمد الحامد يشير إلى أن دور المؤسسات الدينية لا يزال محدوداً، مع وجود محاولات فردية جيدة من بعض أعضاء هيئة كبار العلماء، مثل الشيخ عبدالله المطلق الذي يوصي بزيارة الطبيب النفسي لمرضى الوسواس القهري. ويؤكد أن التعاون الرسمي بين الجهات الطبية والمؤسسات الدينية مطلوب لطرح الموضوع بشكل موضوعي. ويختم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بأن المؤسسات الدينية يمكنها التأكيد على أن المرض النفسي ليس ضعفاً في الدين، وأن العلاج النفسي لا يتعارض مع القيم الدينية، بل يمكن أن يكون العلاج الديني فعالاً عندما يعمل بمحاذاة العلاج النفسي، وذلك من خلال المساجد والمحاضرات التي تنشر رسائل توعوية ضد الخرافات المرتبطة بأسباب الاضطرابات. الفصل الثاني: التحديات النظامية والهيكلية الفجوة بين الحاجة والواقع على صعيد البنية التحتية، لا تزال معظم أنظمة الرعاية النفسية تعتمد على نموذج المستشفيات التقليدية، بدلاً من الرعاية المجتمعية المتكاملة، حيث تمكنت أقـــل مـــن 10 % من الدول من الانتقال الكامل إلى نماذج الرعاية المجتمعية. هذا الاعتماد على التنويم تسبب في مشاكل حقوقية، إذ تتم نصف حالات الدخول إلى المستشفيات النفسية بشكل غير طوعي، وتستمر أكثر من 20% من الإقامات لأكثر من عام. أزمة الكوادر المتخصصة: فجوة عالمية تتسع يمثل النقص الحاد في الكوادر الطبية المتخصصة أزمة عالمية تهدد جودة الرعاية النفسية وتحول دون وصول الملايين إلى الخدمات الأساسية. تكشف الأرقام عن واقع مؤلم: يبلغ المتوسط العالمي 13 عامل صحة نفسية فقط لكل 100,000 شخص، وهو رقم يعكس عجزاً هيكلياً في المنظومة الصحية العالمية. لكن الصورة تصبح أكثر قتامة عند النظر إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث قد لا يتجاوز العدد عامل واحد لكل 100,000 شخص في بعض المناطق، مما يعني أن ملايين البشر محرومون من الوصول إلى أي شكل من أشكال الرعاية النفسية المتخصصة. في الولايات المتحدة، رغم كونها من أكثر الدول تقدماً في المجال الصحي وامتلاكها لأكبر عدد من المختصين النفسيين في العالم، يعيش أكثر من 169 مليون أمريكي في مناطق تعاني من نقص في مهنيي الصحة النفسية، مع متوسط وقت انتظار للحصول على موعد يصل إلى 48 يوماً. هذا النقص لا يقتصر على الأطباء النفسيين فحسب، بل يشمل الأخصائيين النفسيين، والمعالجين السلوكيين، والممرضين المتخصصين، والأخصائيين الاجتماعيين، والمستشارين النفسيين. في المملكة العربية السعودية، تواجه المنظومة الصحية النفسية تحديات مماثلة، حيث يشير المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية إلى أن من أكثر التحديات في هذا المجال ارتفاع نسب الإصابة بالاضطرابات النفسية، مع استمرار النظرة السلبية السائدة لمن يعمل في هذا المجال من طلاب ومتخصصين، وقلة البرامج النوعية في مجال التشخيص والقياس والعلاج، إضافة إلى ضعف العائد المادي مقابل المجهود الذي يقوم به العاملون في هذا المجال. هذا النقص في الكوادر يؤدي إلى سلسلة من التداعيات السلبية: تأخر في الحصول على المواعيد، قصر مدة الجلسات العلاجية، ارتفاع معدلات الإرهاق المهني (Burnout) بين العاملين في المجال، وانخفاض جودة الرعاية المقدمة للمرضى. كما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الانتكاس وزيادة الحاجة إلى التنويم في المستشفيات، مما يزيد من التكاليف الصحية والاجتماعية. مقارنة دولية: الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية تظهر فجوات واضحة في عدد العاملين في المجال النفسي. في الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا، يتراوح عدد الأطباء النفسيين بين 20-30 طبيباً لكل 100,000 شخص، بينما يصل العدد في بعض الدول الإسكندنافية إلى 40 طبيباً لكل 100,000 شخص. أما في الدول العربية، فيتراوح المتوسط بين 2-5 أطباء لكل 100,000 شخص، مما يعكس فجوة كبيرة تحتاج إلى جهود مضاعفة لسدها. هذه الفجوة لا تقتصر على الأطباء فحسب، بل تشمل جميع التخصصات المساندة. في الدول المتقدمة، يوجد نظام متكامل من الأخصائيين النفسيين والمعالجين السلوكيين والأخصائيين الاجتماعيين الذين يعملون جنباً إلى جنب مع الأطباء النفسيين لتقديم رعاية شاملة ومتكاملة. أما في الدول النامية، فغالباً ما يكون الاعتماد على الأطباء النفسيين فقط، مما يحد من فعالية الرعاية ويزيد من الضغط على الكوادر المتاحة. التحديات في السياق السعودي يبرز نقص الكوادر المتخصصة كواحد من أبرز العراقيل التي تعيق النهوض بالخدمات النفسية. ففي السعودية، تشكل أعداد الأطباء النفسيين نسبة ضئيلة مقارنة بعدد المرضى، إذ لا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين المسجلين نحو 0.8 لكل 100,000 نسمة، وهو معدل متدنٍ مقارنة بالدول المتقدمة التي تتراوح بين 10 إلى 15 طبيباً نفسياً لكل 100,000 نسمة. كما يعاني قطاع العلاج النفسي من نقص في المعالجين النفسيين المرخصين، وأخصائيي التمريض النفسي، فضلاً عن قلة برامج التدريب المستمرة التي تؤهل الكوادر لمواكبة التطورات العالمية. ويؤكد المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أن التمويل الحالي لا يكفي للتوسع في الخدمات النفسية، مقترح توسيع التأمين الطبي وتطوير قطاع الأدوية والمراكز النفسية. ويضيف أن بناء قدرات بشرية متخصصة يتطلب برامج تعليمية متقدمة، وشراكات مع مؤسسات تعليمية عالمية، فضلاً عن تحسين بيئة العمل لجذب الكفاءات الوطنية والأجنبية على حد سواء. أما مازن ركيني، فيربط نقص التمويل بعدم تغطية التأمين، ويفسر أن الأموال تتجه نحو النمو السريع، وهو ما لا يتوفر في المجال الطبي. وفيما يتعلق بالبدائل، يشير المركز الوطني إلى أهمية فتح خيارات للرعاية المنزلية بأسعار مناسبة، واستخدام الرعاية عن بعد، وزيادة خطوط الرد الساخن، مع التأكيد على ضرورة تدريب الكوادر المتخصصة في هذه المجالات الجديدة، لضمان جودة الخدمات وفاعليتها. الفصل الثالث: التحديات الطبية والعلمية غموض التشخيص وصعوبة العلاج على عكس فروع الطب الأخرى، لا توجد حتى الآن فحوصات مخبرية أو صور أشعة قاطعة لتشخيص الأمراض النفسية، مما يجعل التشخيص يعتمد على التقييم السريري والملاحظة، مع احتمال اختلاف التشخيص بين الأطباء. تتداخل الأعراض بين اضطرابات مختلفة أو أمراض عضوية، مما يصعب الوصول إلى تشخيص دقيق. من جهة أخرى، رغم فعالية الأدوية النفسية، إلا أن آثارها الجانبية قد تؤثر على جودة حياة المرضى، مثل زيادة الوزن والخمول، مما يدفع بعضهم إلى التوقف عن العلاج، مما يؤدي إلى انتكاسات. يشرح المركز الوطني كيف يمكن تطوير أدوات تشخيص أدق، بالاستفادة من تحديث المعايير والتصنيفات، وتصميم برامج علاجية تتناسب مع السياق الثقافي، واستعمال الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج. أما لتقليل الآثار الجانبية، فيؤكد المركز أهمية الاستخدام المقنن للأدوية، وإشراك برامج الدعم السلوكي، وتطوير صناعات الأدوية لتوفير خيارات متعددة ذات جودة عالية وأسعار مناسبة. ويقول المركز: “نعم يمكن تطوير علاجات شخصية فاعلة في البيئة السعودية، مستندة إلى التعليم والتدريب وفق معايير عالمية، مع مراعاة القيم الثقافية والاجتماعية.” الفصل الرابع: التحديات المعاصرة والناشئة التكنولوجيا والأزمات العالمية أحدثت التكنولوجيا، ولا سيما وسائل التواصل الاجتماعي، ضغوطاً نفسية جديدة، منها القلق الاجتماعي الناتج عن المقارنة المستمرة، والتنمر الإلكتروني، وإدمان الإنترنت. في السعودية، ساعدت التكنولوجيا، مثل العلاج عن بعد، على زيادة الوصول إلى الرعاية خلال جائحة كوفيد-19، لكنها أثارت مخاوف أخلاقية تتعلق بخصوصية البيانات والتحيز في خوارزميات الذكاء الاصطناعي. أما الأزمات العالمية المتلاحقة، من جائحة وكوفيد-19 إلى الحروب والأزمات الاقتصادية وتغير المناخ، فقد زادت من معدلات القلق والاكتئاب، مضيفة عبئاً هائلاً على أنظمة الصحة النفسية. يقول طلال الجفناوي: “العلاج عن بعد ساعد في الوصول لشريحة أكبر من المجتمع الذين يعانون من صعوبة الوصول للمستشفيات بسبب بعد المسافة أو ازدحام المواعيد.” ويحذر من الإفراط في الاعتماد على الوسائل الرقمية قائلاً: “أنصح أبنائنا وبناتنا بالابتعاد عن تقديم الأسئلة لوسائل مثل GPT، لأن التشخيص يجب أن يكون عبر المختصين والجهات الرسمية.” الفصل الخامس: التحديات الديموغرافية والوبائية الشباب في مرمى الخطر تؤكد الإحصائيات الحديثة أن أكثر من مليار شخص يعانون من اضطرابات نفسية عالمياً، مع إصابة نحو 425 مليون بالاكتئاب، ويعاني 25% من سكان العالم العربي من القلق، بينما أودى الانتحار بحياة نحو 727,000 شخص في عام 2021. وتُظهر البيانات أن 75 % من الاضطرابات النفسية تبدأ قبل سن الخامسة والعشرين، مما يجعل فئة الشباب والمراهقين الأكثر عرضة للخطر، كما تتأثر النساء بشكل غير متناسب، خصوصاً في السعودية. أ. عناصر يجب أن تتضمنها المناهج والأنشطة المدرسية 1. وحدات قصيرة عن الوعي بالصحة النفسية: تشمل معرفة المشاعر، مهارات تنظيم الانفعالات، وأساليب مواجهة القلق والضغوط اليومية. 2. مهارات اجتماعية وحل النزاع وبناء المرونة النفسية عبر أنشطة عملية تفاعلية تشرك الطلاب في سيناريوهات واقعية. 3. تدريب المعلمين والموظفين على “الإسعاف النفسي المدرسي الأولي” وكيفية اكتشاف العلامات المبكرة للاضطرابات النفسية وإحالة الحالات بشكل سريع وآمن. 4. أنظمة إحالة واضحة تربط المدرسة بالمراكز الصحية وعيادات الصحة النفسية من خلال خطوط ساخنة ومواعيد عبر التطبيقات الحكومية مثل تطبيق صحتي. 5. برامج لمحو الوصمة: ندوات وورش عمل تشرك الطلبة وأولياء الأمور في حوار مفتوح حول الصحة النفسية، مع مشاركة قصص نجاح لمتعافين. 6. مراقبة دورية سنوية أو نصف سنوية باستخدام أدوات مهنية مع مراعاة الخصوصية والموافقة الأبوية، لتتبع مؤشرات الصحة النفسية للطلاب. ب. آليات التنفيذ تقترح الزكري آليات تنفيذ واضحة تشمل: - تدريب مركزي للمعلمين على مستوى وزارة التعليم، بالتعاون مع وزارة الصحة والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية. - إطلاق مواد تعليمية رقمية مرخصة باللغة العربية تكون متاحة لجميع المدارس والجامعات. - إدراج مؤشرات الصحة النفسية ضمن مخرجات المدارس ومراجعتها سنوياً كجزء من تقييم الأداء المدرسي. - دعم هذه الجهود بتكامل قطاعي بين التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، مع تحديد مسؤوليات واضحة لكل جهة. الفصل السادس: بين القيم والتحديات رحلة الشباب في قلب التحولات الاقتصادية والاجتماعية في عالم تتقاطع فيه التوقعات الأسرية والمجتمعية مع قيم الشباب، يشعر كثيرون بأن قيمهم “لا تتناسب” مع ما يُنتظر منهم. هنا، تبدأ الوقاية من الاضطرابات النفسية برعاية جذرية: تواصل صحي في البيت، ومساحة آمنة في البيئة التعليمية، ورؤية مجتمعية تحترم الطاقة الإنسانية وتقدرها. يؤكد فهد الربيش، الأخصائي النفسي الحاصل على ماجستير علم النفس الإكلينيكي، أن من أبرز العوامل الاجتماعية المؤثرة في ازدياد الاضطرابات النفسية لدى فئة الشباب هي الوصمة الاجتماعية التي تفرضها الأسرة أو الأقران، حيث ينظر البعض إلى طلب المساعدة النفسية على أنه ضعف أو عيب، كما يلفت إلى نقص الوعي والمعرفة بالعوامل المؤثرة على الاستقرار النفسي، خصوصاً أن الشباب يتسمون بالأندفاعية وتغيرات فسيولوجية ومشاعر متقلبة، مما يجعل الثقافة بالصحة النفسية ضرورة ملحة لهذه الفئة العمرية. إلى جانب ذلك، يبرز الضغوط الاقتصادية كعامل مؤثر؛ إذ تمر هذه الفئة بمرحلة انتقالية من الاعتماد على الأسرة إلى الاعتماد على الذات، غير أن التأخر الدراسي والبطالة وضعف الدخل تعيق تحقيق هذا التوازن، فتعمق من الأعباء النفسية. خلال العقد الماضي، شهدت المملكة العربية السعودية تحولات اقتصادية كبرى، منها أنه أصبح اقتصاد تنافسي يرتكز على الكفاءة، والإنتاج، وريادة الأعمال. هذا التحول، رغم أهميته وضرورته، خلق حالة من القلق لدى بعض الشباب، إذ تراجعت القيم التقليدية حول “الوظيفة الآمنة”، وأصبح النجاح مرتبطًا بمهارات جديدة وسرعة تكيف في سوق عمل أكثر تنافسية وأقل ضمانًا. وتقول الدكتورة بسمة حلمي، مديرة مشروع تعزيز الرفاه والعافية النفسية في مؤسسات التعليم العالي: هناك تقدم جيد لكنه غير كاف حتى الآن، حيث ان المدارس في المملكة ما زالت بحاجة إلى نظام رصد وإحالة موحد، من خلال بروتوكول إحالة واضح يربط المدرسة بالمراكز الصحية النفسية المحلية أو خدمات وزارة الصحة والقطاع الخاص، مع حماية الخصوصية للشباب وولي الأمر، وما زال منسوبي المدارس بحاجة إلى تثقيف وتوعية وتدريب في كيفية الكشف المبكر للأعراض النفسية ومعرفة عوامل الخطورة التي تحتاج إلى تحرك سريع. ويمكن دمج الصحة النفسية في المناهج الدراسية لدعم الشباب من خلال دمج مؤشرات الصحة النفسية ضمن تقييم جودة المدارس، وغرس المهارات والمفاهيم النفسية داخل المواد والممارسات اليومية في البيئة التعليمية، مثل: إدماج المفاهيم النفسية في المواد الدراسية، إضافة منهج مخصص لمهارات الحياة والصحة النفسية، تدريب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس على “التربية النفسية”، تقديم أنشطة تعزيزية للصحة النفسية داخل البيئة التعليمية، دمج العناية النفسية في النظام التعليمي، كما أن تفعيل دور المرشد الطلابي والمرشد الصحي مهم جدا في تعزيز الرفاه والعافية النفسية داخل البيئة التعليمية. توجد العديد من المبادرات الفعالة التي أطلقتها مجموعة من الجهات ذات العلاقة مثل المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية والذي كان له جهود كبيرة في الاهتمام ببرامج تعزيز الصحة النفسية في المدارس والجامعات، حيث اطلق المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية مجموعة من الأدلة الإرشادية مثل : الدليل الارشادي للتعامل مع مشكلات الصحة النفسية في البيئة المدرسية لتعريف منسوبي التعليم بالمشكلات النفسية وآلية التعامل معها، والدليل الارشادي للتعامل مع حالات إيذاء الذات والانتحار في البيئة الجامعية ، وهو دليل ارشادي وقائي للتعامل مع عوامل الخطورة والفئات الأكثر عرضة ، كما أطلق المركز مبادرة نوعية تعنى بتعزيز الصحة النفسية في جامعات المملكة منذ عام 1437 ، “ كضرورة حتمية، باعتبارها من أكثر المؤسسات مساهمة في تشكيل الوعي وتغيير السلوك لكبر حجم الشريحة الشبابية المنتمية لها وتنوع خصائصها، وما زالت تحتاج هذه المبادرات إلى الدعم والتعاون للوصول بها إلى الهدف المرجو منها، كما أن هناك العديد من الجهود المميزة والمثمرة من قطاعي التعليم والصحة والتي تعتبر نواة لتطبيق أوسع لمفاهيم الصحة النفسية وتعزيز الرفاه والعافية النفسية في البيئة التعليمية. من جانبها، ترى عائشة الزكري أن المناهج التعليمية بحاجة إلى إعادة نظر جذرية تدمج مهارات الحياة والعافية النفسية بشكل تفاعلي وحيوي، لتزويد الفتيات بالوعي الضروري لمواجهة هذه الضغوط، وإدارة القلق، وتنمية المرونة النفسية. وتشدد على أهمية وجود مستشار نفسي أو أخصائي صحة نفسية في كل مجموعة مدارس، إلى جانب اعتماد فحص نفسي دوري موحد في مراحل التعليم المختلفة كخطوات واقعية وجوهرية. رؤية متكاملة للوقاية إن حماية الشباب من هذه التحديات تتطلب رؤية شمولية تجمع بين التمكين الاقتصادي، وتعزيز العلاقات الأسرية والمجتمعية، وتوسيع خدمات الدعم النفسي والاجتماعي في المؤسسات التعليمية والعملية. فالمناعة النفسية لا تُبنى في العيادات فقط، بل تبدأ من بيئة اجتماعية داعمة، واقتصاد يضمن الاستقرار. الوقاية الأسرية: حضن يحتوي لا يقيد تبدأ الوقاية في الأسرة التي يجب أن تكون بيئة داعمة لا متسلطة. وهذا يتطلب الحد من الخلافات الأسرية، وتعزيز التواصل عبر جلسات يومية للحوار والاستماع دون إصدار أحكام، وتحويل التربية من نمط التوجيه إلى الاحتواء. الوقاية الاقتصادية: استقرار مالي ينعش النفس يُعد الأمان المالي جزءاً لا يتجزأ من الأمان النفسي، لذلك يجب توسيع فرص العمل المستقرمثل العمل عن بعد أو الدوام الجزئي بما يتناسب مع مؤهلات الشباب، ونشر الوعي المالي بينهم لتعليمهم إدارة الدخل والاستهلاك وتجنب ضغوط المظاهر والديون. الوقاية التعليمية: المدرسة والجامعة ملاذ آمن ترى عائشة الزكري أن الجهود الرسمية مثل برامج التوعية الصحية المدرسية التابعة لوزارة الصحة، واندماج خدمات الصحة في منصات وطنية صحية كـ«صحتي»، تشكل قاعدة جيدة لكنها لا تكفي. فهي تدعو إلى تعزيز دور المدارس كمراكز أولية للصحة النفسية، من خلال توفير مستشارين نفسيين متخصصين، وإجراء فحوص نفسية دورية مع آليات إحالة فعالة، وذلك لضمان رصد المعوقات النفسية مبكراً، خصوصاً بين الفتيات اللاتي يحتجن إلى دعم خاص يتناسب مع تحديات المرحلة العمرية والمجتمعية التي يعشنها. بهذا التكامل بين آراء المختصين، والوقائع الاقتصادية والاجتماعية، يتجلى أمامنا مسارٌ واضح نحو بناء جيلٍ شابٍ يمتلك من الوعي والمرونة ما يمكنه من مواجهة تحديات العصر، متسلحاً بدعم أسري ومجتمعي وتعليمي يراعي خصوصيته ويحتضن طموحاته. الفصل السابع: تحديات التشريعات والعلاج التمييز الاجتماعي والحماية القانونية رغم التقدم في اعتماد سياسات داعمة للصحة النفسية، إلا أن الإصلاحات التشريعية لا تزال غير كافية، إذ تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن 45% فقط من الدول لديها قوانين تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. يوضح سامي الزهراني، أستاذ مساعد في علم النفس الإكلينيكي بجامعة الإمام محمد بن سعود، أن التمييز غالبًا ما يكون غير مباشر، متجذرًا في الثقافة الاجتماعية حيث تُعتبر الوصمة الاجتماعية المرض النفسي ضعفًا في الإيمان أو الشخصية. الاعتماد على الأدوية ونفوذ شركات الدواء ينقل لنا د. عبدالله أحمد الوايلي، أخصائي نفسي عيادي وجنائي، وجهة نظر متعمقة حول الاعتماد المفرط على الأدوية النفسية في الممارسة الطبية السعودية. يقول: “أجزم بأن هناك اعتمادًا مباشرًا وكاملًا على الأدوية النفسية للأسف الشديد، ويعود ذلك إلى سيطرة المدرسة الطبية النفسية على العملية العلاجية في السعودية، رغم وجود محاولات متواضعة من بعض المتخصصين في العلاج النفسي العيادي.” واقع العلاج النفسي السلوكي تؤكد سندس الساعاتي، أخصائية ومعالجة نفسية، أن الاعتماد على الأدوية منتشر بسبب عدة عوامل، منها عدم توجيه الأطباء المرضى للعلاج السلوكي المعرفي، وعدم توفر الأخصائي النفسي في العيادات، وصعوبة الحصول على مواعيد منتظمة للعلاج. عبء التكلفة تكلفة العلاج النفسي تشكل عائقًا كبيرًا. تتراوح كلفة الاستشارة النفسية في العيادات الخاصة بين 250 و500 ريال سعودي في العادة، وقد تصل في بعض الحالات إلى 1000 ريال للساعة. يوضح سامي الزهراني: “التكلفة العالية للعلاج النفسي في السعودية تُعد من أبرز العوائق التي تؤثر على التزام المرضى بالاستمرار في العلاج، خاصة في ظل محدودية التغطية التأمينية وخدمات الصحة النفسية المجانية.” الفصل الثامن: نحو علاج متكامل أهمية مشاركة الأسرة في مساحات التشخيص النفسي، كثيرًا ما تعتمد المعلومات على رواية المريض وحده، مما قد يؤدي إلى تشخيص ناقص أو مضلل. يشرح سامي الزهراني: “في كثير من المراكز النفسية مثل مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض، يُشجَّع إشراك الأسرة في مراحل التشخيص والعلاج بحيث يُطلب منها تقديم معلومات عن تاريخ المريض، سلوكياته، والتغيرات الملحوظة، مما يساعد في بناء صورة تشخيصية دقيقة.” الأدوية متعددة الاستطباب تُستخدم بعض الأدوية النفسية لعلاج أكثر من اضطراب نفسي، لكن هذه الأدوية غالبًا ما تسيطر على الأعراض دون معالجة الأسباب الجذرية. يجيب سامي الزهراني: “الأدوية متعددة الاستطباب تُستخدم غالبًا لإدارة الأعراض عبر أكثر من اضطراب، لكنها لا تعالج الجذور النفسية أو الاجتماعية للمشكلة، وقد تكون جزءًا من خطة علاج طويلة الأمد، لكنها ليست كافية وحدها.” التكامل بين العلاج النفسي والدوائي يُبيّن الوايلي: “الجمع بين العلاج النفسي والدوائي يؤدي إلى نتائج أفضل، فالعمل الجماعي مثمر وأفضل بكثير من الاعتماد الأحادي، خاصة في حالات الصحة النفسية المتوسطة والشديدة.” نحو مستقبل أفضل للصحة النفسية رغم حجم التحديات العميقة التي تواجه الصحة النفسية، تلوح في الأفق بوادر أمل مشرقة. فقد شهد العالم زيادة في الوعي بأهمية الصحة النفسية، وتقدمًا ملموسًا في دمج خدمات الصحة النفسية ضمن أنظمة الرعاية الأولية، وتوسعًا كبيرًا في استخدام التقنيات الرقمية لتقديم الرعاية. تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن 80% من الدول أصبحت تقدم الدعم النفسي والاجتماعي كجزء من استجابتها للطوارئ، مقارنة بـ 39% فقط في عام 2020. وفي المملكة العربية السعودية، بدأت مبادرات وزارة الصحة تعزز الوعي وتوفر خدمات العلاج عن بعد، إلا أن الطريق ما زال يتطلب المزيد من الجهود. ولا يمكن تحقيق هذه الطموحات دون وجود كوادر متخصصة ذات كفاءة عالية، تشكل العمود الفقري لأي نظام صحي نفسي فعال. فالكوادر المتخصصة في هذا المجال تشمل الأطباء النفسيين الذين يملكون خبرات عميقة في تشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية المعقدة، والأخصائيين النفسيين الذين يقدمون الدعم النفسي والعلاجي بأساليب متعددة مثل العلاج السلوكي المعرفي والعلاج النفسي الديناميكي. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الممرضات النفسيات بأدوار حيوية في رعاية المرضى ومتابعتهم، فضلاً عن اختصاصيي العلاج الوظيفي الذين يساعدون المرضى على استعادة مهاراتهم الحياتية والاجتماعية. تتطلب هذه التخصصات برامج تدريبية متطورة ومستدامة، تشمل تحديثًا مستمرًا للمعارف والمهارات، وتوفير بيئات عمل محفزة تضمن استقرار هذه الكوادر وتطورها المهني. وفي السعودية، تشهد الأكاديميات والمراكز التدريبية تطورًا ملحوظًا، مع إطلاق برامج دراسات عليا متخصصة، وشراكات دولية لتعزيز القدرات المحلية. إلا أن الحاجة لا تزال قائمة لتوسيع هذه البرامج لتشمل مناطق أوسع، مع التركيز على التدريب العملي الميداني الذي يؤهل هذه الكوادر لمواجهة الواقع المتنوع والمتغير لمشكلات الصحة النفسية. إن مواجهة هذه التحديات العميقة تستدعي جهدًا منسقًا وشاملًا من الحكومات والمؤسسات الصحية والمجتمع المدني والأفراد. وينبغي أن تركز الجهود على: - زيادة التمويل للصحة النفسية - مكافحة الوصمة الاجتماعية من خلال حملات توعية قائمة على الأدلة - تطوير القوى العاملة عبر برامج تدريب متخصصة ترفع من جودة الكوادر المتخصصة وتحفز استقرارها - تعزيز نماذج الرعاية المجتمعية التي تحترم حقوق الإنسان وتضع المريض في مركز الاهتمام فالاستثمار في الصحة النفسية ليس مجرد ضرورة إنسانية، بل هو استثمار في مستقبل أكثر صحة وعدالة وازدهارًا للجميع. وبتعزيز الكوادر المتخصصة، نضمن أن يكون لهذا الاستثمار أثر عميق ومستدام، يفتح آفاقًا جديدة أمام المجتمعات نحو حياة أكثر توازنًا وسعادة.
