الكتابة كخلاص.. كيف ننقذ ذواتنا بالحبر؟
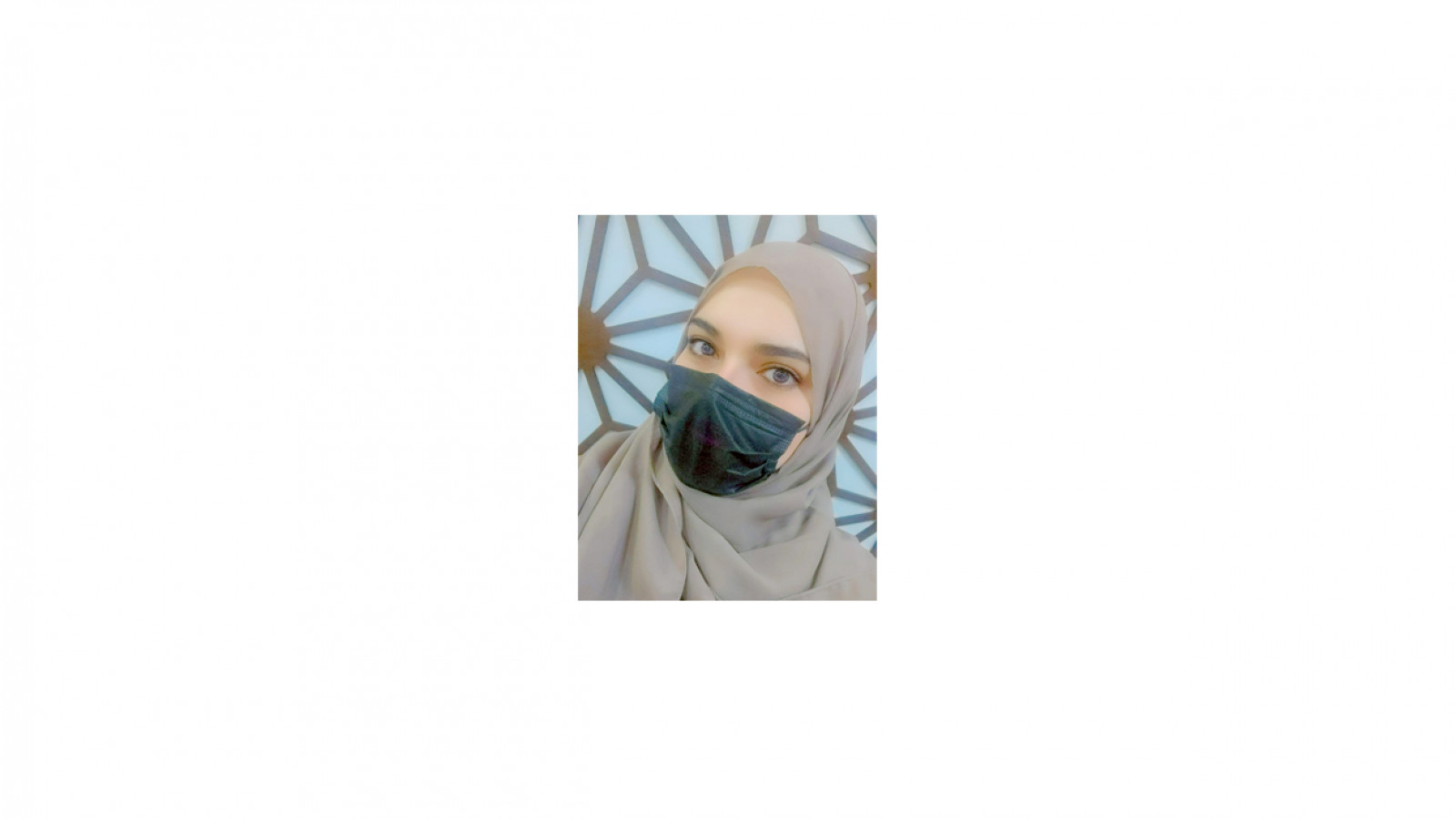
حين يضيق العالم بالروح، لا يبقى أمام الإنسان سوى أن يلوذ بالكلمة. الكتابة ليست حبرًا مسكوبًا على الورق، ولا ترفًا كما يظن البعض، بل هي جسر يمتد بين الذات والعالم، بين اللحظة العابرة والخلود. هي فعل نجاة خفي، ومحاولة لترميم الذات الواقعة في شرخٍ بين ما نعيشه وما نشعر به. إنها تجربة لإنقاذ النفس التائهة بين ما يمكن قوله وما يعجز اللسان عن الإفصاح به. الكتابة فعل يتجاوز حدود الزمان والمكان، يخلّد الأفكار والمشاعر، ويعيد تشكيل الهوية الفردية والجمعية معًا. إنّها اللغة التي نتنفس بها حين تخذلنا اللغات، والملاذ الذي نلوذ به حين تضيق الجهات. الذاكرة — كما يقال — خائنة، تشبه بحرًا تأكل أمواجه سواحل الماضي رويدًا رويدًا، حتى تذوي المعالم وتغرق التفاصيل الثمينة في أعماق النسيان. وهنا تبرز الكتابة كفعل خلاصٍ أول؛ خلاص من ضياع الهوية. فالإنسان في جوهره مجموع ذاكرته، وكل حرف محاولة لالتقاط لحظة كانت ستضيع لولا الحبر. نكتب لأننا نخاف الفقد، ولأننا نحاول أن نحفظ ما يتسرب منا بصمت لا يُرى. ربما لهذا السبب، حين نكتب نشعر أننا نرتّب الفوضى داخلنا، كأننا نزرع في الورق جذورًا جديدة لذواتنا. الكتابة ليست استعراضًا للوعي، بل مصالحة مع الألم. الكاتب الحقيقي لا يكتب ليدهش، بل ليشفع. في كل نصّ يودع شيئًا من القديم بين الكلمات، يضع اعترافًا لم يجرؤ على قوله. فالحبر ليس لونًا، بل أثر لرحلة داخلية لا يعرفها إلا من سار في عتمة ذاته باحثًا عن الضوء. نحن لا نكتب ما نتذكره كما هو، بل كما شعرنا به. فالنص ليس مرآة الماضي، بل تأويله. من هنا تنبع فرادة الكتابة، إذ تتحول الذكرى في يد الكاتب إلى جمالٍ خالص، ويتحوّل الألم إلى فن. فالكتابة ليست تسجيلًا للأحداث، بل إعادة تشكيلٍ لها، ومنحها معنى ومأوى آمنًا خارج حدود الجسد. هي الوشم الذي ننقشه على جلد الوجود لنقول به: كنت هنا، عانيت، فرحت، أحببت، وعشت. لكن الخلاص بالحبر لا يقف عند حدود التوثيق، فهناك فجوة بين حبر الذاكرة وحبر الإبداع. عندما نكتب من الذاكرة، نحن نختار وننتقي ونركّب، نسلّط الضوء على تفاصيل ونخفي أخرى. نحن لا نكتب ما حدث فعلًا، بل ما نعتقد أنه حدث، أو ما نريده أن يكون قد حدث. هنا تتحوّل الكتابة من حفظٍ للماضي إلى فهمٍ له، من البكاء عليه إلى التحرر منه. ونرى في تجربة محمود درويش مثالًا حيًّا على هذا الخلاص الإبداعي. فقد حوّل ذاكرته الشخصية، وذكرى نزوحه من قريته «البروة»، إلى أسطورة شعرية تُخلّد ذاكرة شعب بأكمله. لم يكن يكتب عن منزله المهدم كحادثة فردية، بل كان يخلق من حجارة بيته كلماتٍ تزن الأرض. عبر قصائده تحولت الذاكرة الفردية إلى ذاكرة جماعية، وجرحه الشخصي إلى هوية قومية. لقد وعى درويش هذا الدور الخلاصي جيدًا، حين قال: «سجّل! أنا عربي.»، محولًا الكتابة إلى فعل وجودٍ ومقاومةٍ للنسيان. من «ألف ليلة وليلة» التي خلّصت الحكايات من الضياع، إلى «مذكرات آن فرانك» التي أنقذت قصة من النسيان، إلى قصائد درويش التي حفظت للقضية الفلسطينية روحها، نرى كيف تتحول الكتابة من فعل خلاصٍ شخصي إلى ضميرٍ جمعي. ورغم ذلك، تبقى الكتابة ذلك التناقض الجميل؛ محاولة يائسة لإمساك اللحظة وهي في طريقها إلى الزوال. هي فعل إيمان رغم كل شيء: إيمان بأن الحياة يمكن صياغتها، وأن للألم قيمة يمكن استخلاصها، وللجمال بقاء يمكن تدوينه. هي الوردة التي نقدمها لأنفسنا في مواجهة صحراء النسيان القاحلة. بين الحبر الذي يسيل على الورق، والذاكرة التي تتسرب من بين الأصابع، يخلق الإنسان الكاتب خلاصه بكلمة، ويقول للعدم — على طريقة درويش —: «سجّل... أنا هنا.»
